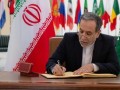الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
هل من دور لـ«حماس» في اليوم التالي؟

بقلم - عمرو الشوبكي
مهما استمرّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومهما سقط من الضحايا والشهداء، فإنَّ هناك نهاية مؤكدة لهذه الحرب، وهناك يوم تالٍ «بعد أن تسكت المدافع» (عنوان كتاب شهير للكاتب والمفكر المصري الراحل محمد سيد أحمد نُشر في سبعينات القرن الماضي)، وإنَّ سؤال اليوم التالي تفكر فيه أوروبا وأميركا وإسرائيل، ولا يزال العالم العربي والسلطة الفلسطينية في مرحلة رد الفعل على كثير من هذه الأفكار المتعلقة بمستقبل قطاع غزة ودور «حماس» ومشروع الدولة الفلسطينية.
صحيح أن قضية اليوم التالي مرتبطة بنتائج المواجهات الجارية حالياً في قطاع غزة، وأن نجاح إسرائيل في إضعاف الوجود العسكري لـ«حماس»، وإخراج قادة الصف الأول من القطاع وعلى رأسهم السنوار أو تصفيتهم كما ترغب، سيجعلها صاحبة القرار الأساسي في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وأنها ستحكم القطاع عسكرياً وأمنياً، وستترك إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين من خارج «حماس».
وإذا لم تحقق إسرائيل هذا الهدف فإنها ستكون بلا شك أضعفت حركة «حماس» عسكرياً، ولكنها لم تقضِ عليها أو كما قال جوزيب بوريل، لن تستطيع إزالتها لأنها «فكرة» وآيديولوجيا، والمطلوب إعادة طرحها بشكل أفضل.
ومن هنا فإنَّه لو حققت إسرائيل أهدافها، فإنَّها لن تنجح في اجتثاث «حماس»، فما بالنا لو لم تنجح في تحقيق أهدافها؟ فإن هذا يعني أن الأخيرة ستظل حاضرة بصور مختلفة عقب انتهاء الحرب.
والحقيقة أن سؤال صيغة أو مستقبل «حماس» عبّر عنه كثير من السياسيين والخبراء، وهناك مَن سار في ركب الرواية الإسرائيلية، ورأى أن القضاء عليها هو الحل، وهناك مَن تأكد بالعلم والخبرات التاريخية قبل الموقف السياسي أنه لا يمكن القضاء على حركة مقاومة ما دام هناك احتلال، وبالتالي تحت كل السيناريوهات ستبقى «حماس» موجودة في اليوم التالي حتى لو لم تشارك في أي مفاوضات مع دولة الاحتلال.
والحقيقة أنه بحسابات الورقة والقلم فإن «حماس» يجب أن تكون حاضرة بشكل مباشر في أي مفاوضات، سواء كانت لهدنة أو لوقف إطلاق النار؛ لأنها ببساطة المسؤولة عن كل ما جرى عقب عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول)، سواء فيما يتعلق بالحراك الكبير الذي حدث حول القضية الفلسطينية، وطرح حل الدولتين بعد طول ركود وموات، كما أنه لولا هذه العملية لما دفع الشعب الفلسطيني هذا الثمن من دماء أبنائه، ولكانت غزة على حالها باقيةً، بدلاً من أن تكون مدمرة كما يرى البعض.
ولذا بدت معادلة «حماس» نادرة الوجود وغير متكررة في تجربة أي حركة تحرر في العالم كله، فحتى لو كان المحتل يرفضها ويعدّها حركة إرهابية، فإنه في لحظة معينة يضطر أن يتفاوض معها؛ لأن يعلم أن ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الحرب والاحتلال، وهو أمر لم تحصل عليه «حماس» رغم بعض الإرهاصات التي يرددها بحذر شديد بعض قادة الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز التأكيد على أنها فكرة وآيديولوجيا، وليست مجرد جماعة متطرفة كما يرى الإسرائيليون والأميركيون.
ومن هنا فإن تجاهل «حماس» دولياً وإسرائيلياً سيظل معنا حتى اليوم التالي، ولكن استمرارها سيظل معنا أيضاً بعد اليوم التالي، ويصبح السؤال: ما دورها والصورة التي يجب أن تكون عليها لتصبح جزءاً من المسار السياسي الفلسطيني؟
إذا نجح المجتمع الدولي، عقب توقف الحرب، في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المهدرة منذ أكثر من نصف قرن، وانسحبت إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عقب حرب 1967، وقامت الدولة الفلسطينية، فإن ذلك سيفرض على «حماس» أن تتغير، وسيعطي شرعية للجميع بجعل السلاح فقط في يد السلطة الفلسطينية الجديدة، وليس في يد أي فصيل من فصائل المقاومة.
من المهم بناء تيار جديد يعبّر عن مشروع سياسي جديد لـ«حماس» يتجاوز مشروعها القديم، ويفكك الجناح العسكري إذا نجح المجتمع الدولي في فرض حل الدولتين على إسرائيل، وهو مشروع سيظل خيالياً ما دام الوضع الحالي باقياً دون تغيير.
إسرائيل تهيمن عليها أحزاب وتيارات سياسية متطرفة تحرّض على القتل والتهجير والإبادة الجماعية، ولكنها جزء من «الملعب السياسي» ويقبلها العالم ويختلف معها، وطبيعي أن تضم الدولة الفلسطينية متشددين ومعتدلين، وإصلاحيين وثوريين، وليبراليين ومحافظين، وهو أمر ستجد «حماس» الجديدة نفسها جزءاً منه.
«حماس» ستبقى، فلا يمكن القضاء على حركة مقاومة أو فكرة آيديولوجية بالقنابل والصواريخ والمجازر الجماعية، صحيح يمكننا أن نخرج من داخل «حماس» تياراً سياسياً إصلاحياً إذا سرنا في مسار تسوية سلمية يستبعد كل الخيارات العنيفة والمسلحة، أو يخرج منها تيار متشدد وعنيف إذا بقيت السياسات الإسرائيلية في القتل والتهجير والاحتلال على حالها.
حديث اليوم التالي سيأتي آجلاً أم عاجلاً بـ«حماس» الضعيفة أو القوية، إلا أنها في كلتا الحالتين ستظل باقيةً، والمطلوب عدم السير وراء الأوهام الإسرائيلية التي تتحدث عن القضاء الكامل والاجتثاث لتبرير قتل المدنيين، إنما يجب دعم خيار تغيير «حماس» ودمج تيارات متدينة ومحافظة من خارجها في مشروع وخط سياسي جديد قد يكون متشدداً أو محافظاً، ولكنه في الحالتين سيتجاوز «حماس» القديمة.
GMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!GMT 23:09 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
هل يمكن خلق الدولة في لبنان؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - مصر اليوم
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©