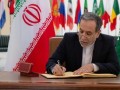الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
مشكلة السلطة في النظام الإيراني

بقلم - عمرو الشوبكي
وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتحت الباب مرة أخرى أمام مناقشة طبيعة النظام السياسي الإيراني وإمكانات تطويره وإصلاحه وبأي شكل ومسار. والحقيقة أن السمة الأساسية للنظام السياسي الإيراني، ومشكلته أيضاً، تكمنان في تلك الازدواجية الموجودة داخل السلطة التنفيذية بين المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية؛ فالأول هو القائد الفعلي للبلاد وهو أقوى مركز للسلطة في إيران ويرتبط بنظرية ولاية الفقيه التي وضعها قائد الثورة الإيرانية (1979) الإمام الخميني ومرشدها الأول، فهو القائد العام للقوات المسلحة بأفرعها، وله حق إعلان الحرب والسلم، وتعبئة القوات المسلحة وتعيين وعزل 6 أعضاء من علماء الدين في مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية والقائد الأعلى لـ«الحرس الثوري»، كما لدى المرشد ممثلون يعيّنهم في كل وزارة أو مؤسسة حكومية مهمة، ويتدخلون في جميع شؤون الدولة. وترتكز السياسة الخارجية الموازية التي يمارسها المرشد على المكاتب الثقافية للسفارات الإيرانية والتي تتبعه مباشرة، وتتولى إيصال الدعم المالي إلى الحركات الإسلامية «الصديقة» حول العالم، متخطية بذلك رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. يقيناً صلاحيات المرشد أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي إشكالية ركز البعض في نقدها على كون المرشد رجل دين، ولكنّ هناك جانباً آخر يتعلق بأنه يمتلك سلطة مطلقة وصلاحيات هائلة أكبر بكثير من صلاحيات الرئيس والبرلمان. والسؤال المطروح: هل يمكن إجراء خفض تدريجي لصلاحيات المرشد، وبخاصة مع وجود مؤشرات تقول إن المرشد القادم أياً كان اسمه، سيفقد جانباً جديداً من البريق والحضور الشعبي الذي يمتع به قائد الثورة الخميني، وإن حضوره خارج المجال الديني أو بعيداً عن أدوات السلطة المطلقة في تراجع؟ يقيناً هناك تركيز على مدار أربعة عقود على الاحتجاجات كطريق «لإسقاط نظام الولي الفقيه»، وذلك منذ الاحتجاجات على خسارة مير حسين موسوي الانتخابات الرئاسية في 2009، وحتى احتجاجات 2022 التي اعترضت على مقتل الفتاة مهسا أميني في أحد مخافر الشرطة بعد أن أوقفتها «شرطة الأخلاق» تحت حجة أنها لا ترتدي الحجاب «بشكل مناسب»، وهاجمت صلاحيات المرشد ودعت لإنهاء حكمه. إن نظرية القطيعة وإسقاط النظام لم تنجح في إيران رغم كثرة الاحتجاجات التي شهدتها، وهي ليست وصفة سحرية حدثت في كل التجارب ومع كل النظم، بما يعني أن نظام ولي الفقيه رغم أبعاده الدينية وسلطويته، فإن تغيير طبيعته ربما ستكون أقرب لطريقة تطور النظام السياسي البريطاني وليس على طريقة الثورة الفرنسية، بما يعني إمكانية تحول الولي الفقيه من حاكم فعلي للنظام القائم، إلى قائد معنوي ورمز روحي، وهو مسار تاريخي بالمعنى الثقافي والسياسي لن يحسم في يوم وليلة، إنما يمكن أن يكون خياراً أكثر ملاءمة للواقع الإيراني والثقافة السياسية في هذا البلد أكثر من مسألة القطيعة الكاملة مع النظام ونسخ نظام غربي. في بريطانيا مثل ملكيات دستورية كثيرة، ينظر إلى السلطة الملكية بوصفها «فوق السلطة» الحاكمة، تتسع فيها صلاحيات الملك في وقت الأزمات والحروب الكبرى، وهو ضامن للنظام القائم من انحراف الحكومة والسلطة التنفيذية. والحقيقة أن الوصول إلى صيغة «الملكية الضامنة» لم يكن بين ليلة وضحاها، إنما كانت نتاج تراكم طويل، فلنا أن نتصور أن بريطانيا عرفت بدايات التراكم في اتجاه بناء دولة القانون والملكية الدستورية عقب صدور «الماغنا كارتا» أو الميثاق الأعظم، في 1216، الذي تحول في عام 1225 إلى قانون ملزم؛ أصلحوا من خلاله نظامهم الملكي ولم يسقطوه، كما حدث في تجارب أخرى. يقيناً لا توجد علاقة بين تاريخ النظام في إيران وتاريخ النظام الملكي في بريطانيا، لكن جوهر الفكرة أن إصلاح معظم النظم السياسية في العالم وحتى تغييرها، لم يتم بقطع الرقاب كما جرى في الثورة الفرنسية (1789) والثورات الشيوعية، أو بإحداث قطيعة «بكبسة زر» بين القديم والجديد، وأن الرهان على مدار 40 عاماً على حدوث ثورة «ضد نظام الثورة» في إيران لم ينجح، وربما سيكون الخيار الذي اقتربت منه إيران من دون أن تدري هو التخلي تدريجياً عن نظام الولي الفقيه.
أرى أنَّ مستقبل النظام السياسي الإيراني وإصلاحه سيكونان باكتفاء المرشد بأن يكون قائداً روحياً يرشد الناس للقيم الدينية وفق الثقافة الشيعية، وأن يكون الرئيس المنتخب في انتخابات تنافسية حرة هو الحاكم الفعلي للبلاد.
GMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!GMT 23:09 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
هل يمكن خلق الدولة في لبنان؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - مصر اليوم
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©