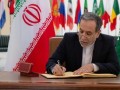الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
المعتاد الجديد في الشرق الأوسط

بقلم: عبد المنعم سعيد
أكثر الكلمات شيوعاً الآن في أدب أزمة «كورونا» هي «المعتاد الجديد» أو (The New Normal)، وهو ما سوف تحصل عليه المجتمعات تدريجياً بعد القرار بفتحها مرة أخرى إلى نوع ما من الحياة «الطبيعية». الفكرة نظرياً هي أن المجتمعات تحب دائماً أن تعيش وفقاً لما هو معتاد أو روتين للحياة تكفل انتظامها ومعيشتها في سلام ووئام، حيث تتوزع أدوار الإنتاج والتكاثر والاستهلاك وتوالي الأجيال وهكذا أمور. ولا يعني ذلك أن الحياة تكون راكدة فهناك دائماً من التناقضات التي عندما تنفجر بالثورة أو الحرب أو الكوارث الطبيعية، فهذه تكون سبباً في قطع ما هو جائز ومعتاد أو ما يقال «Disruptive» لما هو عادي. وربما الأمر يشبه نوعاً من قوانين الطبيعة، أو طبيعة المجتمعات على الأقل، في أنها تميل عندما تختل توازناتها، إلى أن تعيد هذا التوازن مرة أخرى، ولكنه لا يكون ذلك التوازن السابق بالضرورة، وإنما في العادة يكون توازناً جديداً بشكل أو بآخر حيث تحل مجموعات من الإضافات محل ما كان معتاداً. المثال الشائع في ذلك أن ما كان معتاداً قبل حدوث العمليات الإرهابية أن المسافر يذهب إلى المطار وفي داخله يصل إلى مكاتب شركات الطيران، حيث يقوم بشحن حقائبه، ثم يمضي إلى مكتب الجوازات حيث يختم جواز سفره ومنها إلى باب السفر.
بعد الإرهاب بات ضرورياً وجود بوابات لكشف المعادن المتفجرة، وفحص الحقيبة الخاصة التي يسافر بها، وبعد ذلك بات عليه خلع الحذاء والحزام الذي في خصره والتخلص من كل النقود والمعادن التي يحملها لمعرفة الوقت أو على سبيل الزينة، وفي النهاية بات مطلوباً منه الحضور إلى صالة السفر قبل موعد الطائرة بثلاث ساعات يقضي نصفها على الأقل في عمليات تفتيش متنوعة. عملية السفر، أي ما كان معتاداً، ظلت كما هي ولكن المعتاد الجديد كَمَن في الإجراءات. المتصور أن ما بعد «كورونا» سوف يشهد في السفر أيضاً إجراءات إضافية بعضها في أوراق السفر حيث تضاف شهادة الخلو من مرض «كورونا» اللعين، وهي شهادة سوف تضع مواصفاتها منظمة الصحة العالمية، وبعد ذلك تضاف أجهزة إلكترونية تستشعر حالة حرارة المسافرين، ومن يعرف، ربما تُؤخذ عينة من الدم للتعرف على حالة الأجسام المضادة. السفر يظل ممكناً، ولكنه ليس كما كان معتاداً، سيكون معتاداً جديداً.
حينما عرضنا من قبل للحالة العالمية وكيف ستضع أزمة «كوفيد – 19» بصماتها على العالم، كان المنطق هو أن الأزمة كاشفة أو أنها دافعة للتناقضات القائمة بالفعل، فلا شيء يُخلَق من عدم. في الشرق الأوسط، مثل ذلك يحدث أيضاً، ففي مطلع العام كان خلاصة العقد الماضي في الإقليم أن ما سُمي الربيع العربي خلق حالة من الفوضى والخلل في دول عربية خاصة دفعت بالدول الإقليمية للتدخل: إيران اندفعت في اتجاه بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. تركيا في اتجاه شمال سوريا. إسرائيل في اتجاه الضفة الغربية الفلسطينية بالمزيد من الاستيطان والضم. إثيوبيا تجاه مياه النيل بإقامة سد النهضة على الحدود السودانية. الدول العربية التي لم تمسسها الفوضى دخلت في مسار طويل من الإصلاح العميق الممتد حتى عام 2030. قبل نهاية العقد جرى حراك شعبي آخر في أربع دول عربية هي الجزائر والسودان ولبنان والعراق، كانت له نتائجه، هي الأخرى عبّرت فيها عن رفضها للتدخل الأجنبي وطرحت مساراً إصلاحياً يقوم على الدولة الوطنية.
جائحة «كورونا» جاءت خلال الشهور الأولى من العام الحالي لكي تضع كل هذه الاتجاهات في الحالة الشرق أوسطية موضع الاختبار، وكانت النتيجة الأولى هي أن الدول الإقليمية التي تدخلت في الشؤون الحيوية لدول عربية زادت من درجة تدخلها وعدوانيتها، فرغم أن إيران اعتراها الكثير من الألم بسبب الفيروس، فإن تدخلها في البلدان العربية التي تدخلت فيها ظلت على عنفوانها، كان الخيار الإيراني هو الاستمرار في العدوان وليس إنقاذ الشعب الإيراني. تركيا لم تتغير هي الأخرى رغم عنفوان الإصابة بالمرض، وبدلاً من الانسحاب من سوريا توغلت أكثر، كما نقلت الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، وبدأت عمليات عسكرية في الغرب الليبي لمساندة حزمة من الجماعات الإرهابية. إسرائيل طرحت بوقاحة شديدة أن تبدأ حكومتها الجديدة حياتها السياسية بالضم الرسمي للأراضي الفلسطينية. إثيوبيا خرجت دون توقيع من مفاوضات واشنطن مع مصر والسودان بخصوص مياه النيل، وقامت بالاعتداء على مناطق في شرق السودان. النتيجة الثانية هي أن الدول العربية التي أخذت مسار الإصلاح قبل «كورونا» وجدت أن ما حققته من قبل في هذه المسيرة أعطاها الكثير من القدرة والمَنَعَة لكي تواجه الجائحة من ناحية، وأزمات انخفاض أسعار النفط من ناحية أخرى، وأن تواجه أزمات التدخلات الإقليمية في ذات الوقت.
هكذا يبدو «المعتاد الجديد» في الشرق الأوسط أن جائحة «كورونا» قد زادت الدول الإقليمية سعاراً في محاولاتها للتوسع والنفوذ على حساب الدول العربية؛ وأن الجائحة تثبت لدول الإصلاح العربي أنها على الطريق السليم، وأن تحقيق معدلات عالية للنمو هو ضرورة للدولة سواء كانت نفطية أو غير نفطية، وأن تنويع مصادر الدخل هو حتمية تفرضها التقلبات العالمية في عالم ما بعد «كوفيد -19». ما ينقص الساحة الإقليمية، وكان مطروحاً في وقت «المعتاد القديم» أنه بالإضافة إلى ما اعترى دولاً عربية من خلل داخلي نتيجة الحراك الشعبي الكبير، أن هناك خللاً في التوازن الإقليمي تحاول الدول الإقليمية غير العربية أن تستغله. وما عزز من هذا الخلل كان الانسحاب الأميركي من الإقليم الذي بدأ في سوريا والعراق، وختمته الإدارة الأميركية مؤخراً بتوقيع معاهدة سلام مع جماعة طالبان الأفغانية تنسحب بمقتضاها أميركا ودول حلف الأطلنطي الأخرى من أفغانستان وتتركها لمصيرها المشبع بالتطرف. وعلاج هذه الحالة من الخلل يبدأ بالإصرار على الاستمرار في طريق الإصلاح بسرعة وعمق أكثر من أي وقت مضي، وفي هذه الحالة فإن «كوفيد - 19» الذي أثبت صمود القدرات الصحية في الدول العربية الإصلاحية، فإنه في نفس الوقت فتح الباب لكي يكون القطاع الصحي من القطاعات الواعدة بالمزيد من النمو في اتجاه الخدمات التي يقدمها، وأيضاً في اتجاه جعله صناعة متكاملة تكون لها عوائدها الكبيرة.
ولكن الإصلاح لكي يكون أسرع وأعمق، وأكثر من ذلك يسهم في تصحيح التوازنات الإقليمية، لا بد له أن يتم في إطار إقليمي يقوم على السوق الإقليمية العربية على جانبي البحر الأحمر التي توفر من المستهلكين والمنتجين ما يوفي بالاحتياجات الصناعية والزراعية –والغذاء خاصة– اللازمة للدول العربية المعنية. بمعنى آخر فإن البعد الإقليمي العربي لا بد أن يكون جزءاً من «المعتاد الجديد» في الشرق الأوسط. وإذا كانت الدول الإقليمية المعتدية تتصرف معنا كعرب، فلماذا لا نواجها كعرب أيضاً؟!
GMT 23:29 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعةGMT 23:27 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
نحن عشاق «الكراكيب»GMT 23:25 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
التوت و«البنكنوت»GMT 20:38 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
الصفقة مع ايران تأجلت... أو صارت مستحيلةGMT 07:51 2021 السبت ,11 أيلول / سبتمبر
الملالي في أفغانستان: المخاطر والتحديات"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©