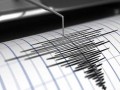الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
حكايات السبت

بقلم - محمد السيد صالح
السياسة والرياضة
الاستغلال السياسى للرياضة قديم جداً، بل يمكن القول ببساطة إن البطولات العظمى على مدار التاريخ وُلدت لأهداف سياسية. هكذا انطلقت الأوليمبياد فى أثينا القديمة، وهكذا استقرت واستمرت، وتصارع على استضافتها الزعماء الليبراليون والديكتاتوريون على السواء. لكن يبقى الهدف واحداً، وهو استغلال شعبية الرياضة فى الدعاية السياسية للدولة وللنظام الحاكم. فعلها هتلر فى أوليمبياد برلين عام 1936، حين أبهر العالم، خاصة شبابه ورياضييه بحسن التنظيم وبعظمة ألمانيا، وكان يجهز فى الخفاء لاجتياح أوروبا. كانت الدول الشيوعية مغلقة سياسيًا واقتصاديًا، قاسية على شبابها وسفره، خاصة للعواصم الغربية، ولكن حين كانت تأتى «الأوليمبياد» نفاجأ بشباب مختلف، يحصد الذهب مؤمنًا ببلده وبتفوقه، لا أنسى تفوق الاتحاد السوفيتى وألمانيا الشرقية ورومانيا ويوغسلافيا وبلغاريا على معظم الدول الغربية. فى المقابل، كانت الولايات المتحدة ومن بعدها الصين واليابان تواجه هذا الطوفان الأحمر بالعلم والتخطيط، إلى أن زاحموا فى حصد الميداليات، ثم تفوقوا على الدول الشرقية مع انهيار الشيوعية فيما بعد. الولايات المتحدة لديها نظام حوافز رياضية ليتنا نقلدها بجد وفوراً.
الكشافون يجوبون ملاعب المدارس فى كل الألعاب، لديهم عقود وموافقات جاهزة من إدارات الجامعات بمنح دراسية مضافة إليها مكافآت مالية مجزية للاعبين الموهوبين. قرأت مقالاً متخصصًا أن الغالبية الساحقة لحاملى الذهب فى الولايات المتحدة سواء من الرجال أو النساء هم من طلاب الجامعات أو المدارس العليا. غابت عنا الملاعب فى المدارس والجامعات بفعل فاعل. لم أرَ وزيراً للتعليم أو التعليم العالى يحضر بطولة فى المدارس أو الجامعات. أعود بذاكرتى إلى مدارس قريتى عندما كنت طالبًا، أو كما يحكى إخوتى الكبار أو أرى فى صورهم، كانت لديهم ملاعب ومدربون فى كل الألعاب تشبه الموجودة فى الدول الشرقية. أين ضاعت، ولماذا، ومن المسؤول؟!.. أستطيع بسهولة أن أحدد الفترة الزمنية والحكومة المسؤولة أو الوزير المسؤول حينها، لكننى لا أعفى أبداً القيادة العليا فى ذلك.
سيدى الرئيس، إنه قرارك، لكننا سندعمك فيه. خذ قراراً فوريًا بشأن الرياضة. لقد زرت المنتخب لتشجيعه والشد من أزر لاعبيه قبل مونديال روسيا، لكن كنا نعلم أنهم ذاهبون لحصاد اللا شىء. ليس لدى هذا الجيل ما يقدمه. لم نتخذ لهم نموذجًا يتعلمون منه. تركنا الأندية لمجموعة من الأفاكين والكذابين وأصحاب الضمائر الخربة.
أتمنى أن تبتعد «الأجهزة» عن مساندة ودعم هؤلاء. تتركهم لمصائرهم. أعرف زملاء مثقفين ومحترمين انتخبوا هؤلاء فى أنديتهم الجماهيرية، لا شىء إلا «أن الدولة تدعمهم وتوظفهم وتريدهم هكذا. يفسدون فى الأرض وفى النوادى». لن نتقدم هكذا. نريد منك سيدى الرئيس عندما تزورهم قبيل أى بطولة مقبلة أن تكون واثقًا بأن أبناءك يستحقون ثقتك، وأننا جهزناهم لهذه المهمة بشكل جيد. وأن تكون لديك القناعة- ونحن معك- بأننا أحسنا الاختيار. كشافونا جابوا البلاد بحثاً عن المصريين الموهوبين. لتختار سيدى الرئيس مصريًا عاش فى عاصمة غربية- ولتكن أمريكا أو ألمانيا- ليدير هذه المنظومة، وندعمه بكل الإمكانيات وليكرر ما فعلوه هناك. لقد قرأت هذا الأسبوع ما أزعجنى حقًا بشأن نسب عدد لاعبى كرة القدم فى عدد من الدول التى تألقت فى كأس العالم بالمقارنة بمصر. لدينا 10 آلاف لاعب كرة مسجلون، أما ألمانيا فلديها 6 ملايين لاعب مسجلون فى اتحادهم، رغم أن عدد سكانهم حوالى 80 مليونا. الولايات المتحدة ورغم أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى فيها، بها 4 ملايين لاعب ولاعبة. أيسلندا التى وصلت دور الثمانية فى بطولة أوروبا الماضية، وتعادلت مع الأرجنتين فى المنافسات الجارية حاليًا، لديها 25 ألف لاعب مسجل، رغم أن سكانها يقلون عن النصف مليون. مطلوب اهتمام حقيقى بالأندية والأكاديميات المتخصصة فى كل لعبة.
الاهتمام السياسى بالرياضة ينبغى أن يتم على أسس علمية، حتى لا تكون الرياضة وهزائمها عبئًا على النظام ومثاراً للسخرية، بدلاً من الدعاية للدولة ولرئيسها.
فيلم الإسكندرانى
انتهى «مولد» المونديال بالنسبة لمصر، ولكن كسبنا عدة إعلانات جاءت قوية للغاية. وأزعم أن مستواها الفنى- معظمها على الأقل- أقوى مما كنت أشاهده على محطات غربية كبرى. شدنى أكثر إعلان «WE»، وسر نجاحه ظهور سمير الإسكندرانى فيه، وأداؤه فيه لأغنية «يا للى عاش حبك يعلم جيل من بعد جيل» فى روسيا دعمًا للمنتخب القومى. أما الإعلان الآخر فهو استخدام لحن «شدى حيلك يا بلد» لمحمد نوح فى إعلان أورانج. فكرة الإعلان رائعة.
سمير الإسكندرانى فنان عملاق، وتاريخه السياسى وما قدمه للبلد يستحق كل احترام وتقدير. بل إن ما قام به للمخابرات العامة المصرية يليق به وبنا تقديمه فى مسلسل مستقل.
وهذه رسالة للجهاز الوطنى، وأقول للمسؤولين عنه: أنتجتم- وأحيانًا مولتم- أعمالا فنية من أفلام ومسلسلات، بعضها حقق نجاحًا جماهيريًا وماديًا، وبعضها ذهب طى النسيان. لماذا لا تخرجون عملية «الإسكندرانى» إلى النور؟ أعلم علم اليقين أنها كانت جزءًا من عمليات مهمة، وأن دخول الشاب سمير الإسكندرانى بصحبة والده إلى مبنى المخابرات بكوبرى القبة لكى يرشد «الجهاز» ورجاله إلى تعرضه لمحاولة تجنيد من رجال الموساد فى إحدى العواصم الأوروبية فتح أبوابًا كثيرة. أكمل الإسكندرانى ما طُلب منه، وأن يبدى تعاونًا مع عملاء الموساد، ولكن عليه إمدادهم بمعلومات مصدرها رجال المخابرات العامة. أعلم أيضًا أن عملية الإسكندرانى كانت كقطعة فى لعبة دومينو متراصة، وأنها أسقطت عدداً ضخمًا من الجواسيس والشبكات التى كانت تعمل داخل مصر وخارجها. أعلم أيضًا أن «عملية الإسكندرانى» كان يتم تعليم الضباط المتدربين عليها، وكيف أن معلومة بسيطة، أو أن شخصًا بسيطًا حين يطرق بابك ليدلى بمعلومات من منطلق أنه وطنى مخلص فلابد أن تنصت له.
أتذكر أننى قابلته وتناقشنا فى قصته أكثر من مرة، لكن المرة الأولى كانت فى مكتب الصديق مجدى الجلاد- وكان حينها رئيسًا لتحرير «المصرى اليوم»- وتطرق الأمر إلى أكثر من موضوع، وفجأة قلت له: إن الفريق رفعت جبريل «الثعلب» يقدرك كثيراً، فتغير وجه الرجل ثم دمعت عيناه. كان الفريق جبريل قد توفى قبلها بأسابيع، وتحولت الجلسة إلى حكايتهما معًا. نشرت الحلقات فيما بعد، حينما كان الزميل على السيد رئيسًا للتحرير. وأشهد أن «الجهاز» تعامل باحترام وإنصاف معنا، وتم نشر معظم الحلقات حينها. الآن، أدعو لكى تنتج المخابرات عملاً فنيًا متكاملاً عن سمير الإسكندرانى. صدقونى الرجل وعمليته العظيمة يستحقان ذلك.
نقلا عن المصري اليوم
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
GMT 20:22 2023 الخميس ,19 تشرين الأول / أكتوبر
مليونية ضد التهجيرGMT 03:11 2023 الأربعاء ,21 حزيران / يونيو
الخالدون أم العظماءGMT 04:43 2023 الإثنين ,19 حزيران / يونيو
كل سنة وأنت طيب يا باباGMT 04:15 2023 الأحد ,18 حزيران / يونيو
الزعامة والعقاب... في وستمنسترGMT 03:32 2023 الأحد ,18 حزيران / يونيو
حدوتة مصرية فى «جدة»مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز �...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©