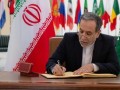الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
عمرو حمزاوى والفريضة الواجبة

بقلم: أحمد الجمال
لا أتذكر، عبر عدة عقود مضت، أن أحدًا أقدم على نقد أفكاره ومواقفه ومسلكه علنًا وعلى شاشة التليفزيون، مثلما فعل الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية والأكاديمى المرموق، الذى يعمل الآن فى مؤسسة أمريكية مهمة، ويتبوأ مركزًا وظيفيًا مهمًا.. أى أنه بالبلدى الفصيح ليس بحاجة إلى التزلف لأحد، ولا إلى البحث عن وظيفة، أو السعى نحو دور.
وقد جاء نقده الذاتى بهدوء واثق، تحدث فيه عن فترة ثورة يناير 2011، ولا أريد أن أكرر هنا ما قاله، لأنه موجود لمن يريد أن يشاهد ويسمع على «اليوتيوب» فى حلقات الأستاذ ضياء رشوان على إحدى المحطات الفضائية.
لم أكن شاهدت الحلقة أثناء بثها، وفى حوار مع أستاذ الأجيال فى العلوم السياسية، الدكتور على الدين هلال، الذى أشرف بالاقتراب منه خلال السنين القليلة الماضية، سألنى: «هل شاهدت حوار ضياء رشوان مع عمرو حمزاوى؟ إذا لم تكن فإننى أدعوك لمشاهدته، ولن أقول لك رأيى حتى تراه ونتكلم»، ومضيت متثاقلًا لليوتيوب وفوجئت بأن التثاقل يتحول تدريجيًا إلى تركيز وإنصات ومراقبة لقسمات وحركات المتحدثين، ثم انبهار بمدى الشجاعة التى تحلى بها الدكتور عمرو، ومدى الدقة فى رصد المواضع الفكرية والمسلكية التى فرضت عليه تأملها بعد أن بعدت المسافة الزمنية وأيضًا المكانية، وأوجبت عليه أن يستجيب لنداء ضميره الوطنى وتكوينه العلمى اللذين يفرضان على أى إنسان أن يبدأ بنفسه، إذا كان المقام مقام تصويب وسعى للحقيقة، وأيضًا مقام تقديم القدوة للأجيال الطالعة، خاصة إذا كان المرء أستاذًا جامعيًا مسؤولًا عن تكوين عقول الأجيال وصقل معارفها وتدريبها على الموضوعية والمنهج النقدى.
لقد مارس الدكتور حمزاوى، بل أحيا، فريضة غابت عن حياتنا بوجه عام، وحتى فى المجالات التى يفترض فيها أن يتمتع المنتمون إليها والمشاركون فيها بقدر من السمات التى لا تتوافر عادة فى مجالات غيرها، فإن الفريضة غابت ولم نسمع أو نشاهد زعيمًا حزبيًا أو شخصية عامة أو ناشطًا سياسيًا أو رئيسًا لجامعة وأعضاء هيئات تدريس أو صحفيين كبارًا وأصحاب أقلام يفترض أنهم يصوغون الرأى العام ويوجهونه، أو دعاة من ذوى اللحى الضخمة أو غير الضخمة وهلم جرا، يقدمون نقدًا ذاتيًا يذكرون فيه ما اقتنعوا بأنهم أخطأوا فيه أو انتقصوا من تفاصيله التى رأوا أنها لا تخدم هدفهم، أو تتفق مع وجهة نظرهم، أو ثبت أنه كان مبنيًا على معلومات مضللة أو ناقصة أو محرفة، سواء كان الخطأ فى فكرة أو حديث أو خطبة أو مظاهرة أو عمل مشترك مع آخرين.
ويمتد هذا النقد الذاتى إلى ما هو أيديولوجى أو مصلحى ويتعين أن يمارسه المرء، حتى إن مرت السنون فلا مجال لشماعة التقادم، فى أمور هى من صميم الحياة العامة، وترتبت عليها تطورات ثبت أنها أضرت بالوطن أو بالدولة أو بأحد عناصر الدولة، وهذا ما فعله الدكتور حمزاوى الذى كان يمكن أن يكتفى بالابتعاد المكانى والزمانى عن موقع الأحداث محل النقد، وأن يكتفى بما حازه من سمعة سياسية كناشط وقيادى سياسى فى الميدان إبان الثوة، وفى معظم ما ترتب عليها من أمور، جعله لامعًا تسلط عليه وعلى آرائه الأضواء، ثم يكتفى ويحتمى بما حققه فى الخارج، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى مؤسسات علمية وفكرية مرموقة.
وبالمناسبة فإن السؤال وارد عن كاتب هذه السطور، وقد كان فيما مضى له دور ما فى الحركة السياسية المصرية، حيث كانت الحركة الطلابية مطلع السبعينيات قلب تلك الحركة السياسية، وشغل مواقع حزبية وتنظيمية متقدمة، هل نقد نفسه ذاتيًا؟ وهل قدم التيار السياسى الذى انتمى إليه والأوعية الحزبية والتنظيمية المختلفة التى عبرت عن ذلك التيار نقدًا ذاتيًا؟ والإجابة عن نفسى- وليس عن غيرى- نعم، قدمت نقدًا ذاتيًا فى العديد من الجلسات السياسية، وأكتب هذا النقد الذاتى لنفسى، ولذلك التيار، فى مذكراتى التى أتمنى أن تنتهى وتصدر قريبًا.
لقد تمنيت أن يقدم الذين شاركوا فى التمهيد ليناير 2011، سواء فى الجامعات أو الأحزاب أو الجمعيات الأهلية، أو التكوينات التى ظهرت وقادت التحركات الشارعية، نقدًا ذاتيًا يضع النقاط على كثير من الحروف، التى هى أسئلة تبحث عن إجابات.. أسئلة بغير حصر، أهمها: كيف خذل الثوار الثورة؟.
تحية للدكتور حمزاوى الذى قدم نموذجًا محترمًا لممارسة الفريضة الواجبة
GMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!GMT 23:09 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
هل يمكن خلق الدولة في لبنان؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - مصر اليوم
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©