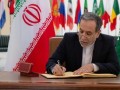الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
سقطة أخرى في الكابيتول

بقلم:سوسن الأبطح
يصل بنيامين نتنياهو إلى أميركا ويداه ملطّختان بدماء عشرات آلاف الفلسطينيين، تاركاً خلفه آلاف المعوقين ومبتوري الأطراف، عدا اليتامى والثكالى، وأكثر من مليون جائع، وحرباً مشتعلة لا تزال تحصد الأبرياء.
سقطة جديدة للديمقراطية الأميركية... استقبال وتكريم شخص مُدانٍ من أغلب المنظمات الإنسانية، وتستعدّ المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة توقيف بحقه، وتطارده المظاهرات التي تطالب بمحاسبته أينما حلّ. تلك حادثة سيسجّلها التاريخ؛ لأنها «المرة الأولى التي يعطَى فيها مجرم حرب شرف إلقاء خطاب أمام الكونغرس»، كما علّق السيناتور بيرني ساندرز.
نتنياهو ارتكب مختلف الجرائم والمخالفات، متّهم بقضايا فساد بصفته رئيس وزراء، وبإبادة شعب، وسرقة وبناء مستوطنات على ما يقارب نصف أراضي الضفة الغربية، واللائحة تطول.
يأتي الاستقبال بعد أيام فقط من قرار الكنيست رفض إقامة دولة فلسطينية، ونتنياهو نفسه استبق القرار وكأنما يوجّه صفعة لكل القرارات الأُمَمية عندما أعلن: «لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية، ولن يمنعنا أحد من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أي هيئة أخرى».
الكابيتول، الذي يُفترض أن يكون رمزاً لأرقى الممارسات الديمقراطية، يتحوّل إلى مكان لتحطيم صورتها وتشويه سمعتها. قبل استقبال نتنياهو بـ4 سنوات كان الحدث الذي هزّ العالم.
ظن البعض في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2021، أن حرباً أهلية قد نشبت في أميركا، عندما رفض دونالد ترمب هزيمته بالانتخابات الرئاسية في مواجهة جو بايدن، وهاجم آلافٌ من مؤيديه الكابيتول، في مشهد هوليوودي لم تعرف له أميركا مثيلاً في تاريخها. اقتحم مناصِرو ترمب المبنى على المجتمِعين، وحطّموا وكسّروا، وضربوا وقتلوا 5 أشخاص، انتصاراً لترمب الذي رفض الخسارة، ثم تمادى وقال إن النتائج مزوّرة، دون أن يقدّم دليلاً ملموساً، لكنه بقي مُصرّاً على عناده.
أميركا لا يبدو أنها تعباً بأضرار غزوة الكابيتول وأبعادها، أعادت ترشيح ترمب للرئاسة مرة أخرى، وتبيّن أنه لم يُنبَذ أو يُرفَض، بل لا يزال له مؤيّدوه، ومَن يَعُدّونه مُخلِّص البلاد من أزماتها، وأمام هذا الإعجاب اضطر جون بايدن للتخلّي عن ترشّحه تحت ضربات ترمب الساخرة، أقلّها وصفه له بأنه «محتال»، و«مليء بالهراء»، و«لا يمكنه المشي، أو أن يجمع كلمتين معاً».
تحويل اللعبة الانتخابية إلى مجموعة من الشتائم بين مسنَّين، بدلاً من أن يتنافسا على تقديم برامج انتخابية ناجعة، لبلد يعاني التضخم، والديون المتراكمة، وضعف الدولار، لهو في عمق الاهتزاز الثقافي. أما خضوع الناخبين لبروبغندا وسائل التواصل، فهذه مسألة لا تقل خطراً؛ إذ لا شيء يمكنه أن يُقنع محبي ترمب بأن عدد العاطلين عن العمل في أدنى مستوياته في عهد بايدن، عكس ما يُشيع ترمب، وأن الوضع الاقتصادي في زمن هذا الأخير لم يكن أفضل حالاً، على غرار ما يدّعي.
اختلّت الموازين والمقاييس في بلاد العم سام، وانحدرت الحملات الانتخابية إلى درك مَعيب، بمجرد أن تنحّى جو بايدن كانت فيديوهات الهزء من المرشّحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس جاهزة، «إنها مجنونة»، اتهمها ترمب، «أدعوها كاميلا الضاحكة، هل رأيتها تضحك؟»، ثم ينشر فيديو خضع لمونتاج رخيص، يجمع ضحكات هاريس المفرقعة، بشكل متوالٍ، لتبدو كأنها في حالة هستيرية.
في الحملة السابقة نعت ترمب المرأة بأنها «وحش» و«امرأة غضوبة»، وهي ألفاظ تنطوي على بُعد عنصري، وتعبّر عن الصورة النمطية للمرأة السوداء في المجتمع الأميركي.
أضرّت أميركا بالديمقراطية أكثر من الديكتاتوريات المعادية لها، متى كانت أميركا تغفر لمرشّحيها عدم دفع ضرائبهم، أو التحرش بالنساء، أو التنمر على العجز والمرض، ووسْم الآخرين بألفاظ عنصرية؟ تهمة واحدة كانت تكفي لتطيح بالمرشح، فما بالها تسمح بكل ذلك دفعة واحدة؟
يُعيد ويُكرّر المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، تأكيده مسؤولية أميركا الكبرى في إضعاف الديمقراطية وقيمها في العالم، وهو ما سيؤدي في النهاية، إذا لم يتم تدارك الأمر، إلى انهيار غربي، ويعتقد هذا الأنثروبولوجي والمتخصّص في الديموغرافيا، بناءً على أرقام وبيانات، أن أميركا بدأت تُغرق العالم في العنف منذ حرب فيتنام إلى اليوم، بحروب جوّالة لم تتوقف، وصولاً إلى حرب روسيا وأوكرانيا، وهو ما ألحق الضرر بنموذج نجح في أن يكون مشتهى الشعوب، وأعطى أحقية لأنظمة ديكتاتورية تدّعي أنها تقدّم نموذجاً أصلح وأكثر إنسانية، رغم كل ما يقال عنها.
فهل يمكن لكامالا، أو أي مرشح ديمقراطي جديد، أن يُنقذ الديمقراطية الأميركية مما آلت إليه؟
GMT 14:09 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
تركيا في الامتحان السوري... كقوة اعتدالGMT 14:07 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
كيف نتعامل مع سوريا الجديدة؟GMT 14:06 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
سيناء فى عين الإعصار الإقليمىGMT 14:04 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
تنظير في الاقتصاد بلا نتائج!GMT 10:09 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
جنبلاط والشرع وجروح الأسدينGMT 10:08 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
بجعة سوداءGMT 10:07 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
عن «شاهبندر الإخوان»... يوسف نداGMT 10:05 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
لبنان... إلى أين؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©