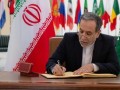الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
جحود من دون وجه حق

بقلم: فـــؤاد مطـــر
كانت حال لبنان إلى ما قبل التئام ممثلي الشرعية اللبنانية الدستورية (نواب البرلمان المتناثر) في المؤتمر الذي سعت إليه المملكة العربية السعودية، حرصاً منها على لبنان، وقوبل السعي وكذلك فكرة انعقاد مؤتمر في مدينة الطائف بترحيب عربي ودولي، مثل حال من تصيبه جرثومة «كورونا» في الزمن الحاضر. جسد منهك وأحياناً متهالك، بمساحة عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرين كيلومتراً مربعاً. تشقق في مؤسسات الدولة. ميليشيات تمارس من أنواع التدمير والقتل ما لم يشهده الوطن اللبناني من قبل. تدفقات من السلاح والمال تصل جواً وبراً وبحراً لأحزاب ورموز جماعات سياسية، رهنت نفسها للشر بدلاً من الخير، ولاستعمال الوطن أرض الأجداد ساحة لتنفيذ مآرب الغريب. قناصة ينشطون في كل أحياء العاصمة بيروت التي بدأت تتحول إلى مدينة أشباح. مؤسسات فندقية تحولت إلى مقرات للميليشيات. ابتكارات لأساليب الهمجية على قاعدة المذهبية، وصلت إلى حد الخطف والسحل والقتل على الهوية أو المتاجرة بالمخطوفين لابتزاز ذويهم. انهيار مؤسسات اقتصادية، وحالات من الشلل في قطاع التعليم عموماً، وفي الجامعات والمدارس الخاصة، انتهت بالإقفال على نحو ما هو حاصل للبعض منها في الزمن الكوروني وتحت تأثير الحالة الاقتصادية. ازدياد حالات الهجرة هرباً عن طريق البحر أو عن طريق سوريا. هكذا كان المشهد بكل محطات الرعب والهلع والضياع.
وإذا جاز القول، فإن الذي كان يحدُث وأوردْنا على سبيل المثال لا الحصر نماذج منه، بدأ يتلاشى بالتدرج بفعل ما حققتْه سفينة الطائف التي كانت معنوياً مثل سفينة نوح، وأمكنها بحكمة من سعى لتفادي سقوط لبنان نتيجة الحرب الأهلية العبثية التي حدثت بافتعال، وفي لحظة تنويم للروح الوطنية في النفس الأمَّارة بالشر، وبالتطلع إلى الاستئثار بالسُّلطة، كما الحال حاضراً، وضْع الوطن فيما يشبه العناية الفائقة، محروساً بكل مقومات العمل على إعادته كما الخارج هذه الأيام من فترة الحجر والعلاج من «كورونا»، يتنفس بطلاقة، ويبدأ الوطن الجريح استعادة الوهج والدور وفق وثيقة دستورية تم وضع بنودها في ضوء مطالب ممثلي الشرعية اللبنانية، والاستئناس باقتراحات كثيرين منهم، من جانب «أطباء» الدبلوماسية السعودية، ومعهم دعماً وتطويراً بعض أُولي الشأن والحنكة عربياً ودولياً.
يحضرنا ونحن نعيش منذ بضعة أشهر حالات كلامية تستهدف النيْل من صيغة توافقية واقعية، ما كانت لتتحقق إلا من خلال السعودية قيادة وشعباً وأرضاً في الوقت نفسه، موقفٌ يتسم بالحكمة والحنكة. فالقيادة السعودية آنذاك أوجزت التمنيات والمشاعر أمام النواب اللبنانيين في جلستهم الأولى لاجتماعات مؤتمر الطائف يوم السبت 1 أكتوبر (تشرين الأول) 1989، بكلام الأخ الذي يريد الخير لأخيه، والمنبثق أصلاً من روحية المملكة، ماضياً من زمن الملك المؤسس عبد العزيز -رحمة الله عليه- وحاضراً في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -سدد الله خطاه- وأزمان إخوانه الذين باتوا في ذمة الله. ولتذكير الذين طالما سجلوا ماضياً ومعهم الذين يسجلون حاضراً مواقف اعتراضية وصلت إلى حد الدعوة إلى اعتبار اتفاق الطائف وكأنه غير مدرج في بند الإنجازات الإنقاذية والإصلاحية العربية، يلفتنا في بعض أوراق وأدبيات تاريخ العلاقات السعودية- اللبنانية مدى رقي التعامل والتخاطب بين الملك عبد العزيز وأول رؤساء لبنان المستقل الشيخ بشارة الخوري، كما نستحضر من كلام راعي مؤتمر الطائف الملك فهد ثلاث عبارات وردت في سياق كلمة افتتاحه المؤتمر. فهو قد قال: «لقد حان وقت الانتقال من التراشق بالمدافع، إلى التسابق على صناعة السلام بالحكمة والتبصر وبالفكر المستنير والرأي الرشيد» و«إن لبنان لم يعد يتحمل مزيداً من النزاعات العقيمة» و«إن الشعب اللبناني الذي ضحَّى كثيراً وقاسى كثيراً، قادر -بإذن الله وعونه- على جعْل وطنه مرة أُخرى نموذجاً للحياة الحرة الكريمة الأصيلة. لقد اختلفت الظروف وتبدَّلت أحوال وتغيَّرت مواقع؛ لكن الجوهر والأساس ظلَّ هو قضية الإنسان، وقضية الحياة، وقضية الدور الذي يجب أن يعود إليه لبنان في شتى المحافل العربية والدولية».
إذا كان الغرض من المطالبات باعتبار مؤتمر الطائف وكأنما لم يحدث، ولم يتوصل إلى الصيغة التي توصَّل إليها، هو النيل من الاستضافة الكريمة للشرعية اللبنانية قبل إحدى وثلاثين سنة، فهذا نوع من الجحود، ذلك أنه بفضل الذي رعى واستضاف وحث وتمنى وساعد، وشارك في ترميم بعض مفاهيم لدى لبنان الإنسان، وكثير تصدعات في لبنان الكيان والبنيان، كان الإنقاذ لما أمكن إنقاذه ولما كان عرضة للتهاوي.
وإذا كان الغرض هو رفْض روحية الوثيقة الدستورية، فإن النيْل من هذه الصيغة هو كذلك جحود دون وجه حق، ومعناه -رغم توضيحات وتنظيرات غير موضوعية- إشعال فتيل بغرض زج لبنان في أتون اقتتال يتخذ هذه المرة الشكل الذي عليه في سوريا وفي ليبيا.
ويبقى القول: إن الذين يتعاملون بعبارات تفتقر إلى الكياسة في موضوع الصيغة الوطنية الكبرى (ميثاق 1943) والصيغة العلاجية الإنقاذية الأُخرى (اتفاق الطائف) ينطلقون فيما يتخذونه من مواقف مبثوثة، إما على الهواء وإما من خلال كلمات تُلقى عبْر الشاشة التلفزيونية خلال مناسبة دينية أو تكريمية، من هوى يتجاوز خارج فضاء الوطن الذي أمعنت النصال الخارجية نزفاً في كبريائه. ولو أن مواقفهم ليست إيرانية الهوى، لأمكن اعتبارها أحد روافد الرؤى في نهر الديمقراطية اللبنانية. لكن الهوى غير اللبناني وغير العربي باستثناء التعبير بلغة الضاد، يُفقد تلك المواقف موضوعيتها، فضلاً عن أن الرجل الأكثر حضوراً في الطيف اللبناني الشيعي الإيراني الهوى (الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله) كان عند بدء الحرب اللبنانية التي أطفأت السعودية لهيبها لم يبلغ العشرين من العمر. أما الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان، فكان ربما لم يولد بعد. وبهذا المعيار يصبح استئناسهما واجباً برؤى متعقلين عاشوا ويلات ذلك الزمن الذي حفل باللاعبين المتلاعبين بالوطن المغلوب على أمره، والأشد قسوة من ويلات الزمن الكوروني الذي نعيشه منذ أشهر، ولا نرى في الأفق ملامح نهاية له. والاستئناس بالرؤى ضروري، علَّ وعسى يقتنع عندئذ دعاة طي صفحة اتفاق الطائف، بكلام قاله الملك فهد في جلسة افتتاح مؤتمر الطائف: «إن الفجر اللبناني آتٍ لا ريب فيه، طال الزمان أم قصر».
والله الهادي لمن ينير ذلك الفجر السبيل أمامهم، ويضع بالتالي حداً لجحوديْن في وقت واحد. والجحود بالنعمة أمر لا يرضاه رب العالمين؛ خصوصاً أن مؤتمر الطائف الذي كان من حيث التشبيه مثل سفينة نوح، أنتج الوثيقة الدستورية التي هي من حيث المقارنة بأهمية اللقاح الأعجوبة الذي تسعى دول العالم المتقدم لاستيلاده، ولم يحالفها التوفيق حتى الآن، بينما عدَّاد الجائحة الكورونية الشريرة يسجل مزيداً من أرقام الضحايا إصابة أو وفاة. ولذا، فإن من واجب كل لبناني، وبالذات الذين في نفوسهم جحود التمسك بتلك الوثيقة، العلاج حتى لا يعود الشر يعصف بالجميع.
GMT 23:29 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعةGMT 23:27 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
نحن عشاق «الكراكيب»GMT 23:25 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
التوت و«البنكنوت»GMT 20:38 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
الصفقة مع ايران تأجلت... أو صارت مستحيلةGMT 07:51 2021 السبت ,11 أيلول / سبتمبر
الملالي في أفغانستان: المخاطر والتحديات"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©