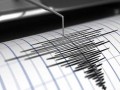الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
أرجوك لا تقل إنه «ركود تضخمي»!

بقلم : د. محمود محيي الدين
مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وصدور التقارير السنوية للمؤسسات الدولية بشأنها، وما يدور من نقاش محتدم عن المسار الذي يأخذه الاقتصاد، تكررت الإشارة إلى ما يسمى بالركود التضخمي.
ظهر هذا المصطلح لأول مرة على لسان السياسي البريطاني المفوّه إيان ماكلاود في عام 1965 عندما كان وزير خزانة الظل لحزب المحافظين المعارض وقتها، وكان ذلك في معرض وصفه لتردي الأوضاع الاقتصادية بقوله: «نعيش اليوم في أسوأ الأوضاع فنحن لا نعاني من حالة تضخم في الأسعار فقط أو حالة ركود فحسب، ولكننا نعاني من تزامن الحالتين معاً بما يمكن اعتباره نوعاً من أنواع الركود التضخمي».
نلاحظ أن ماكلاود، رغم انتمائه للمعارضة، لم يستعمل مصطلح الكساد بدلاً من الركود. ربما يرجع هذا إلى عدم رغبته كرجل دولة في استدعاء مرحلة اقتصادية بائسة سابقة على الحرب العالمية الثانية، وكانت مع معاهدة فرساي سيئة الصياغة وشديدة الانحياز، من مسببات هذه الحرب المدمرة. ومواجهة الركود التضخمي تكتنفها صعوبات معقدة، إذ قد تسبب إجراءات مواجهة مكون الركود في اشتعال التضخم، كما قد يؤدي التعامل مع مكون التضخم إلى استفحال الركود. ولما كان التعامل مع الركود التضخمي بهذه الصعوبة، لم أستغرب ردّ فعل أحد المسؤولين في دولة متقدمة اقتصادياً أثناء اجتماع لمناقشة تقرير عن تطورات الاقتصاد العالمي، كان فيه تفنيد لإشارات محتملة لركود تضخمي بمقولته التي جعلتها عنواناً لهذا المقال، برجائه للحاضرين عدم ذكر مصطلح «الركود التضخمي» وتفضيله وصف الوضع الراهن باختناقات في الأسواق مع ارتفاعات مؤقتة في الأسعار، في محاولة لترشيد التوقعات.
وقبل انتشار هذا المصطلح كان التحليل الاقتصادي يتَّجه إلى تعارض ظاهرتي تضخم الأسعار والركود المصاحب ببطالة وعدم تزامنهما، فإما أن ينخفض التضخم على حساب معدل بطالة أكثر ارتفاعاً أو العكس.
وفي أوقات الرواج الاقتصادي، كالذي شهدته اقتصادات الدول المتقدمة منذ الثمانينات حتى الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اتضح أنه يمكن للنمو الاقتصادي الاستمرار بفضل ارتفاع في الإنتاجية مع انخفاض مطرد في معدلات البطالة والتضخم وتحجيم للتقلبات الاقتصادية. وفسّر الاقتصادي بن بيرنانكي، الذي رأس البنك الفيدرالي الأميركي، ما حدث في هذه الفترة التي يطلق عليها فترة «الاعتدال الكبير» بـ3 أسباب، تمثلت في تغيرات هيكلية إيجابية في الاقتصاد، وتحسن في السياسات الاقتصادية المتبعة، وحسن الحظ! ولكن لم يمر من الزمن أكثر من 4 سنوات حتى واجه الاقتصاد العالمي أكبر أزمة مالية؛ والتي لا يمكن إرجاعها بحال إلى سوء الحظ وحده. فلقد أظهرت الدراسات التي أجريت عن مسببات الأزمة، فضلاً عن تقارير التحقيقات البرلمانية، إلى سوء في الرقابة وتلاعب وتدليس وفشل في الأسواق المالية في القيام بدورها المفترض.
مثلما شهد العالم هذه الحالة من الاعتدال الكبير الذي انخفضت عنده معدلات البطالة ووصلت تغيرات الأسعار السنوية إلى أدناها، فقد شهد أيضاً فترة عصيبة للركود التضخمي في عقد السبعينات من القرن الماضي بارتفاع متوسط معدلات التضخم للأسعار لما يزيد على 7.5 في المائة بسبب زيادة أسعار النفط مع زيادة في معدلات البطالة بما لا يقل عن 6 في المائة، وهذه معدلات شديدة الارتفاع بمعايير أداء الاقتصادات المتقدمة.
وكان لهذه الأزمة، وكذلك ما تم اتخاذه حيالها من إجراءات، تداعيات شديدة الوطأة على اقتصادات الدول النامية التي كانت قد توسعت في الاقتراض الخارجي ثم جاءتها ارتفاعات أسعار الفائدة العالمية بغتة، بما أحدث اضطراباً في أسعار الصرف وتقلبات في التدفقات المالية وعجزاً عن سداد الديون. وقد ترتب على ذلك اتباع إجراءات وسياسات اضطرت دول نامية لاتباعها للخروج من أزمة الديون على النحو الذي شهدته نهايات ما يعرف بالموجة العالمية الأولى للديون.
وقد شهدت الشهور الماضية ارتفاعات متوالية في معدلات زيادة أسعار لسلع متنوعة ومدخلات إنتاج، مثل القطن والأخشاب وأشباه الموصلات، والملابس الجاهزة. ويشير مقال صدر هذا الشهر لفرانسيسكا كاسيلس وبراتشي ميشرا إلى قفزات في أسعار الغذاء بنحو 40 في المائة أثناء انتشار وباء كورونا، بما سبب ضغوطاً على الدول منخفضة الدخل، التي يشكل استهلاك الطعام نسبة كبيرة من الإنفاق العائلي فيها. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، طالبت أنجوزي أوكونجو أيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بالتزام الدول بقواعد التجارة الدولية عموماً، وبتجارة السلع الغذائية خصوصاً، وكذلك التخلي عن الإجراءات المشوهة لتيسير حركة التجارة الدولية في السلع الزراعية والغذائية.
ورصدت مجلة الإكونوميست البريطانية في موضوع الغلاف لعددين متتاليين ظاهرة شحّ المنتجات في الأسواق وما يعتريها من ارتباك لعدم ملاحقة سلاسل الإمداد لزيادة في طلب المنتجين والمستهلكين بعد الجائحة، وكذلك ارتفاع سلة أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي بمقدار 95 في المائة منذ مايو (أيار) الماضي. من السهل إلقاء اللوم فيما يحدث على الجائحة وما سبّبته من مربكات في خطوط الإنتاج ولوجيستيات النقل، لكن لا يمكن تجاهل ما كان متبعاً قبل الجائحة واستمر بعدها من إجراءات حمائية معوقة لحركة التجارة رفعت من الأسعار وخفضت المعروض من السلع. كما أن الإجراءات المرتجلة المتعجلة بضغوط ومزايدات سياسية شوّهت سياسات إدارة التحول نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. فما زالت الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة أقل من مستواها المطلوب بما لا يقل عن النصف، كما تعاني سياسات التخارج من قطاعات الطاقة التقليدية من سوء إدارة لتخارج منضبط للوصول إلى الأهداف الصفرية للانبعاث الكربونية مع حلول عام 2050 أو 2060. وفقاً لتعهدات الدول في اتفاقية باريس للمناخ.
وأحدث هذا الارتباك المتزامن مع تخوف من الإجراءات الرقابية والقانونية انخفاضاً في الاستثمار في الوقود الأحفوري، الذي ما زال المصدر الرئيسي لما يزيد على 80 في المائة من احتياجات الطاقة الأولية بمقدار 40 في المائة منذ عام 2015، وفقاً لمجلة الإكونوميست. ومع تعقد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وفي الوقت الذي تستعد فيه مدينة غلاسكو لاستضافة قمة المناخ ومفاوضاتها، اضطرت دول أوروبية إلى إعادة تشغيل محطات طاقة كهربية تدار بالفحم بعد سنوات من إغلاقها وتعهدات بعدم العودة إليها.
لم تكن في تصاعد الضغوط التضخمية أو زيادة احتمالات ارتفاع الركود مفاجآت تذكر. فقد نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» الغراء مقالاً لكاتب هذه السطور في شهر مارس (آذار) من هذا العام عن تزايد إرهاصات عودة التضخم، أشرت فيه إلى أنه مع تخفيف القيود التي فرضت مع الجائحة سترتفع أسعار السلع والخدمات بسبب ضعف قدرة العرض على ملاحقة الطلب بعد فترة من الإغلاق الكلي والجزئي. وأشرت فيه إلى أنه على الدول الواقعة في تصنيف الوسط التحوط المبكر من أثر تغيرات مباغتة في أسعار الفائدة العالمية، تستهدف الأوراق المالية قصيرة الأجل لاحتواء توقعات التضخم، وما قد يصحب ذلك من تغيرات في أسعار الصرف وارتفاعات في التكلفة الفعلية للديون، خاصة إذا ما خُفضت تصنيفاتها الائتمانية.
وكنت قد أشرت في مقال سابق، نشر في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، عن هواجس الركود واحتمال دخول بعض الدول النامية في فترة قد تطول من انخفاض معدلات النمو عن المتوسط العالمي، وأن ما ذكر حينئذ عن تعافٍ سريع يأخذ مساراً في شكل حرفV أو U يرتبط بالقدرة على زيادة الإنفاق العام والتمكن من الاقتراض منخفض التكلفة، وهو ما لا يتيسر لأغلب الدول النامية.
وفي كل الأحوال، من الممكن التعامل السريع مع هواجس الركود أو إرهاصات للتضخم. ورغم صعوبة هذا، عبّر عنها الاقتصادي ماركوس برونماير، في كتابه الصادر مؤخراً عن المجتمع المرن ذي القدرة السريعة على التعامل مع الأزمات. وهو يُشبّه صانع القرار في زمن الأزمة كمن يقود دراجة هوائية تسير في ممر أعلى هُوّتين على جانبيه، يقودها بحذر، فلا يسقط يميناً حيث هوة الركود، أو يساراً حيث ينتظره فخ التضخم، ولكل من التضخم والركود أدواته المالية والنقدية وإجراءاته الهيكلية في التعامل معه. ولما كنا ما زلنا بعيدين عن هوة الركود التضخمي، وما نجده اليوم ما هو إلا إشارات مبكرة محذرة منه، فما زالت هناك فرص سانحة للتوقي منه. ولا يكون ذلك بتجاهله، أو بافتراضات سخية عن قدرات السوق لتصحيح نفسها، أو عن ميل سلوك الأشخاص لضبط توقعاتهم تلقائياً بما يبعد بهم عن الأذى. فما نعتبره اليوم مؤقتاً في ارتفاع الأسعار قد يطول مداه ما لم تتخذ في مواجهته الإجراءات النقدية المناسبة، وما نفترض أنه من العوارض المؤقتة في سلاسل الإمداد المسببة لنقص السلع والمنتجات قد يتحول إلى مشكلات هيكلية مزمنة، ما لم يتم توجيه الاستثمار في زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير البنى الأساسية. فالوقاية المبكرة خير من العلاج المتأخر. إذ يظل كل هذا يسير التكلفة مقارنة بتكاليف علاج الركود التضخمي، الذي لن يتلاشى بمجرد تجنب ذكر اسمه إذا كان موجوداً بالفعل.
GMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!GMT 23:09 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
هل يمكن خلق الدولة في لبنان؟مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز �...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©