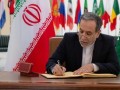الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
وتعطلت «لغة الحرام»

بقلم: د. محمود خليل
الشعوب تفرح بالعطاء، ولا تنشغل بمصدره، ولا تعتنى بأثره على حاضرها أو مستقبلها.
أوائل سبتمبر عام 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة قانون الإصلاح الزراعى، ليحقق واحداً من مبادئ الثورة الستة، المتمثل فى القضاء على الإقطاع.
وزَّع الرئيس عبدالناصر أفدنة باشوات الإقطاع وأمراء العائلة الملكية على الفلاحين، وملَّكهم الأرض. بعدها انطلقت آلة الدعاية التعليمية والإعلامية إلى الحديث عن الاستعمار الغربى والإمبريالية العالمية التى رضيت بأن تكون مصر دولة زراعية، ولا تريد لها أن تتحول إلى دولة صناعية كبرى قادرة على قيادة المنطقة.
أجيال عديدة درست هذه الفكرة فى كتب القراءة، وتربت على عقيدة الدولة الصناعية، وأن الزراعة لا تليق بالشعوب المتحضرة، وكان من بين هؤلاء أطفال ومراهقون من ريفنا الطيب، رسخ فى وجدانهم أن العمل فى الزراعة إرادة من الاستعمار، وليس إرادة أفرزتها وقائع التاريخ أو أنتجتها قوانين الجغرافيا، فرح الفلاح المصرى بالأرض التى حازها، ولهج لسانه بالشكر لجمال عبدالناصر، وابتهج الأبناء بالتعليم والوظائف -بعيداً عن الفلاحة (راجع تبرؤ عبدالهادى النجار من أبيه الفلاح فى رواية زينب والعرش لفتحى غانم).
الكل كان سعيداً، الكبار بتملك الأرض، والصغار بالتعليم، والقيادة بالشعبية التى حققتها. طرف واحد كان يعانى من الاحتقان، هو الملَّاك الذين انتزعت منهم أرضهم. لا بأس أن نقول إن بعضهم أخذها بغير وجه حق وبطرق ملتوية، فتلك حقيقة تاريخية لا يستطيع أن يغفلها أحد، لكن هل توزيعها على الفلاحين كان بحق؟.
انظر إلى المآلات: الأبناء ذهبوا للتعليم والبحث عن الانخراط فى الصناعة، والكبار لم تساعدهم طاقتهم على رعاية الأرض، بدأت رحلة التجريف من أجل البناء، مساحة التربة الزراعية التى حازتها مصر عام 1952، حين كان عدد سكانها 22 مليون نسمة، ثابتة كما هى حتى الآن فى وقت زاد فيه السكان الـ100 مليون نسمة. أقام جمال عبدالناصر -رحمه الله- تجربة صناعية، لكن الإمكانيات لم توفر لها النمو أو الاستمرار، وأهملت هذه المشروعات ولم تجد يداً تمتد إليها لإنقاذها، بل أيادٍ تغرقها.
فرح الشعب بتوزيع الأرض، وانتعشت القيادة بالشعبية، لكن التجربة فشلت، ولم تمضِ إلا سنوات معدودات حتى بدأت الأحزان تتدفق، حين بدأت المؤسسات فى الترهل، والمرافق فى التهرؤ، والاقتصاد فى الترنح، والأرض فى التجريف، والأخلاقيات فى التحلل، والثقافة والتعليم فى التراجع. أما المصانع فحققت بعض الإنجازات، لكنها ظلت تعانى من مشكلات متراكمة، إلى حد أن وصفها خروتشوف فى زيارة له فى مصر بأنها «ورش» وليست مصانع، كما حكى السفير مراد غالب ذات يوم.
شعبنا شغوف بفكرة الحرام والحلال. فهل فكر أحد من أبناء الخمسينات فى حُرمة أو حل الفدادين التى حصل عليها؟. يقول البعض إن الشيخ عبدالمجيد سليم، شيخ الأزهر أوائل الخمسينات تبنى موقفاً معارضاً لقانون الإصلاح الزراعى وأعلن عدم مشروعيته، وذهب إلى أن الحكومة أمامها عدة سبل أخرى لإنعاش الفقراء من خلال رفع قيمة الضرائب، أو باستحداث سياسات جديدة تفتح استثمارات جديدة تستوعب البطالة والفقر.
الشيخ «سليم» كان معروفاً بصلابة مواقفه، وصراحة فتاواه، وعدم اكتراثه بموقف السلطة -حينذاك- من آرائه، وقد أدى على هذا النحو أيام الملك فاروق، وظن أن بإمكانه المواصلة على الوتيرة نفسها بعد الحركة المباركة، فينفعل به الشعب أو يتفاعل معه، ولكن هيهات.. فحيثما ظهرت المصلحة تعطلت لغة الحرام.
GMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!GMT 23:09 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
هل يمكن خلق الدولة في لبنان؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©