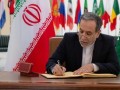الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
على أبواب الجحيم!

بقلم - عبد المنعم سعيد
مررنا توًّا بالذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ التى قطعت فيها مصر مشوارًا طويلًا وصعبًا من ناحية؛ وانتهزت فرصة ثمينة وقوة دفع من ناحية أخرى؛ ولم تسلم طوال الوقت من تحديات جسام لا تزال تواجهها وتصارعها بقدرات كبيرة للصمود والتحمل والإصرار. لم يكن الحال فى نقطة البداية سهلًا بعد سقوط الإخوان، وبصراحة لم يكن لدى القوى الوطنية مشروع وطنى للتغيير اللهم إلا من مجموعة من الشعارات النبيلة. كان الصمود للصعوبات ضروريًّا فى المرحلة الانتقالية، وجرى فيها الانتقال بسلاسة بقيادة الرئيس عدلى منصور أولًا إلى وضع دستور ٢٠١٤، وثانيًا الانتصار فى المعركة مع الإخوان بحماية القوات المسلحة، وعقد الانتخابات الرئاسية التى تولى بعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠١٤. وخلال عشر سنوات بدأت مسيرة كبيرة للتنمية العمرانية لمواجهة أعتى المعضلات المصرية التى قامت على اختلال التوازن ما بين الجغرافيا التى لا يزيد فيها العمران على ٧٪ من المعمور المصرى؛ والديمغرافيا التى بلغت فيها مصر ١١٠ ملايين نسمة، أى زادت مصر بما مقداره ٢٠ مليون نسمة.
تصحيح هذا التوازن كان هو المهمة الأساسية للمشروع الوطنى المصرى، الذى عابه أن المعرفة به فى شموله وأهدافه لم تكن معلومة ولا متداخلة فى الوعى المصرى. التوجه العام ترجمته رؤية ٢٠٣٠ المصرية، وقامت على انتقال التوجه التنموى المصرى من نهر النيل المتكدس بالسكان فى الدلتا والوادى إلى البحار والخلجان المصرية، بحيث بلغ المعمور المصرى قرابة ١٥٪ من المساحة الكلية المصرية؛ بمعدل نمو إيجابى بلغ فى عام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ ما قدره ٦.٦٪. قامت عملية التنمية الكلية على أسس من السرعة والسباق مع الزمن، والرؤية المستقبلية غير المقيدة بتقاليد فترات سابقة قامت فى الأساس على إدارة الفقر فى مصر، وما جاء بديلًا له كان إدارة الثروات المصرية.
كان أهم الإنجازات المصرية قبل نهاية العقد السابق هو القضاء على الإرهاب، الذى بلغت تكلفته الكلية بما فيها تكاليف الفرص الضائعة حوالى ٤٠٠ مليار دولار؛ ومعه تمكنت مصر من القضاء على «فيروس سى» للكبد الوبائى، الذى كانت مصر تتصدر فيه القائمة الدولية. السنوات التالية لم تكن رحيمة بالضغوط التى تولدت من جائحة الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومن بعدها حرب غزة، التى تولدت عنها ارتباكات كبيرة فى التوازن المالى المصرى. ورغم ارتفاع نسب التضخم إلى نسب غير مقبولة، فإن مسيرة البناء ذاتها لم تتوقف، ورغم الادعاءات الكثيرة والحملات الإعلامية من قِبَل الإخوان المسلمين، وما ورد من شكوك «فقه الأولويات» فى ذهن النخبة المصرية، فإن الشعب المصرى تحمل هذه الضغوط من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لم تحدث احتجاجات سياسية، وإنما حدث حوار وطنى، ولا مجاعة، وإنما محض إعادة ترتيب أولويات الأسرة المصرية، ولا أزمة فى الإسكان، وإنما مطالبات بتحرير السياسة الإسكانية المصرية من القيود القائمة عليها من سياسات سابقة، ولا أزمة فى المرور، وإنما سلاسة كبيرة فى الحركة. حدث كل ذلك، بينما بدأت مصر مرحلة لتصحيح الارتباكات الجارية فى اقتصادها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى أو مع الدول العربية الشقيقة أو بالدفع بوزارة جديدة أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الجارية والجديدة.
الآن، ومصر تمر بهذا المنعطف، فإنها تقف على أعتاب أزمة إقليمية عميقة وشاملة للإقليم العربى والشرق الأوسط كله ومدار البحر الأحمر والقرن الإفريقى. الأزمة تفتح أبواب الجحيم من خلال الاحتمال الذى تتوجه إليه القيادات الإسرائيلية لشن الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتربص قوى الحشد الشعبى وحزب الله العراقى للتداخل فى ميدان المعركة من خلال سوريا. المؤكد أن جبهة البحر الأحمر التى حصلت على المزيد من التسلح الصاروخى المتقدم لن تتوانى فى أن يقوم الحوثيون بزيادة هجماتهم على الملاحة والتجارة. أكثر من ذلك، فإن الجماعة اليمنية الموالية لإيران ترغب فى أن تجعل مساحة التصادم شاملة لبحر العرب والمحيط الهندى وربما الخليج أيضًا مثلما فعلت من قبل عندما قامت بقصف مضخات النفط لشركة «أرامكو» السعودية وإمارة وميناء الفجيرة الإماراتى، فضلًا عن مطار أبوظبى الدولى. محصلة كل هذا اللهب هى مواجهة إيرانية إسرائيلية، والمرجح أمريكية أيضًا، تغلق الدائرة بانفجار كبير كله نار ولهب؛ وحرائق تفتح الأبواب مرة أخرى لجماعات إرهابية وميليشيات تعبث بسيادة الدول وكرامتها وربما وجودها ذاته.
هذه النظرة فيها الكثير من التشاؤم والأخذ بأكثر السيناريوهات سوءًا لحركة الأطراف المختلفة فى المنطقة، والتى باتت مصابة بأمرين يدفعان إلى الصدام: أولهما الدفع بالدين إلى ساحة الصراع، وهو ما يعنى تحولًا فى الصراعات المختلفة إلى عمليات «وجودية» يصعب التحكم فيها. التدفق الدينى الكبير على السياسة الإسرائيلية، والذى أفصح عن أكثر التيارات الصهيونية تعصبًا ونية على تفريغ الأراضى الفلسطينية من أهلها؛ أعطى الكثير من الشرعية للكثير من تيارات الإسلام السياسى، التى تتأهب تحت رايات إنقاذ فلسطين لاستعادة ما خسرته بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وثانيهما التهديد الإيرانى من منطلقات شيعية وقومية للهجوم أو لابتزاز شركاء مصر الاستراتيجيين فى الخليج وشبه الجزيرة العربية. النتيجة هى أن المشروع الوطنى المصرى سوف يتعرض لأخطار بالغة تدفع إلى التفكير فى مواجهتها، الآن وليس ساعة حدوثها.
الدول عادة تواجه التحديات الكبرى والمصيرية إما بالاعتماد الكامل على نفسها؛ أو أنها تبنى تحالفًا مع القوى المماثلة لها فى مواجهة الأخطار لموازنة التحالفات المضادة. وبالنسبة لمصر، فإن المرحلة الحالية من تطورها لا تعطيها الفرصة فى الاحتمال الأول، الذى فى الحقيقة لا يمكن تخيله إلا فى الدول العظمى. ولكن وفى الوقت الراهن فإن هناك تحالفًا من إيران مع مجمع الميليشيات فى العراق وسوريا ولبنان واليمن فيما يسمى معسكر «المقاومة والممانعة»، الذى يعتمد ذهنيًّا على فكر الإخوان المسلمين فى المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة. بناء تحالف مضاد لذلك من الدول التى نجت من «الربيع العربى» فى الخليج، ودولة مصر التى أقصت الإخوان، وجميعها تمر بمراحل مختلفة من الإصلاح، وتجتمع على التنمية الشاملة فى الداخل والاستقرار الإقليمى فى الخارج؛ وثقافيًّا تسعى نحو تجديد الفكر الدينى وبناء الدولة الوطنية، التى تقوم على أساس المواطنة والمساواة ورفض التمييز بين البشر على أساس من النوع أو الدين أو المذهب أو اللون. هذه الدول أصدرت بيانًا فى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ فى أعقاب مؤتمر السلام، الذى انعقد فى القاهرة للتعامل مع الحرب التى بدأت بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وجاء فى البيان الكثير من المبادئ الداعية إلى رفض ضرب المدنيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للشعب الفلسطينى وتفعيل عمل السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى. نقطة البداية هذه بما فيها من دعوة إلى الاستقرار وتماثل الرؤى مدعوة إلى بناء تحالف يكون له ما بعده لاستعادة روح الإصلاح فى المنطقة.
GMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!GMT 23:09 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
هل يمكن خلق الدولة في لبنان؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©