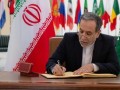الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
كم دفعتم لإيقاف الكبتاغون؟

بقلم:عبد الرحمن الراشد
نحن في موسم التهويلِ السوري، مسلسل قصير آخر. عن العلاقة بين الرياض ودمشق، نسمع حكاياتٍ عن المدفوعات المالية لوقف تهريب الكبتاغون، وتمويل لإعادة الإعمار، وتمويل لإرجاع سوريا إلى الجامعة العربية. الروايات الباطلة عادة تتبخر بنهاية موسمها. وكما قال ملك الحيرة قديماً:
قد قِيلَ ذلك إنْ حقاً وإن كذباً ... فما اعتذارُك من قولٍ إذا قيلَا
كم دفعتم لإعادة سوريا للجامعة العربية؟ لا أحدَ دفع، ولن يدفع أحدٌ، دولاراً مقابل عودةِ أي دولة للجامعة العربية ولا للدول المعارضة. في الأساس، العودة مطلبٌ سوري، دمشق تعتبره مقعدَها، ولا تزال تحتفظ بمقاعدِها في كل المنظمات الدولية، وأهمها الأمم المتحدة. ولو أنَّ المعارضة تسلَّمت الحكمَ كانت ستجلس على المقعد نفسه، كذلك، لكنَّها لم تنجح. أيضاً، عودة سوريا لن تغيّر في موازين قوى المنطقة؛ لأنَّها ليست عودة مرتبطة بتغيير المواقف والمحاور.
عودة المياه إلى مجاريها تؤدّي للمصالحات، التي بدورها تهدئ الأوضاع. كما فعلت مصالحات حكومة إردوغان مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ إذ عادت السياحة، والتجارة البينية، وتوقف الإعلام عن التراشق. لم تتغيَّر المنطقة كثيراً بعدها، ولم تتوقَّف الحروب الأخرى. في عودة حكومةِ الأسد، كل الدول، باستثناء ثلاث، لها علاقةٌ مع دمشق، والثلاث ستعيد علاقتَها معها قريباً. والمأمول أن تُسهمَ المصالحات بين دول المنطقة في إعادة معظم السوريين إلى بيوتهم وأهلهم.
ماذا عن الثمن؟ من المستبعد أن تحصلَ دمشقُ على دولار واحد لقاء «منجزات» عودتِها للجامعة، وإعادة العلاقات، بما في ذلك التعاون في وقف عمليات تهريب الكبتاغون للسعودية؛ لأنَّ مكافأة كهذه ستحفز دولاً أخرى على التهاون مع مهربي المخدرات للمساومة عليها، وهكذا.
المكافأة المحتملة لقاء التعاون في محاربة المخدرات هي السماح بالتجارة، برفع الحظر، والتعاون الاقتصادي، الذي يعود بالنفع على الجانبين. الدول التي تتهاون في أن تصبحَ مصدراً أو ممراً للمحظورات، مثل المخدرات والسلاح، لاحقاً تدفع الثمنَ بالتضييق على الواردات منها، الزراعية والصناعية والخدمية. والعكس كذلك صحيح؛ إذ إنَّ غيابَ العلاقة والتبادل التجاري يسهل من تهاون هذه الدول، فلا يوجد لها مصالحُ تخشى عليها.
ويبقى أكثر الأسلحة فاعلية في يد الحكومات المزدهرة إقليمياً، هو العقوبات الاقتصادية، بإغلاق أسواقها في وجه دول التهريب ودول المرور. وتُبنى جدران عالية وطويلة، والاستعانة بالقوات المسلحة، وقوات الحدود، وقوات مكافحة المخدرات للتضييق على محاولات التهريب بالنسبة للدول التي سلطتها ضعيفة أو فاشلة.
التهريب يبدو سلعةً مربحة، لكنَّه سلاح ذو حدين. إيران كانت، ولا تزال، ترانزيت، ومعبراً كبيراً عالمياً للمخدرات من أفغانستان؛ الأفيون والهيروين والكوكايين والحشيش. التهريب، الذي منح نظام طهران شيئاً من المال وقت الضائقة، نفسه أصابها في مقتلين؛ فقد انتشرت المخدرات داخل بلادها حتى أصبحت وباءً خطيراً، وضيّقت معظم الدول، التي لها علاقة معها، على بضائعها من عبور حدودها.
ورغم ضخامة الأموال لا يكسب الاقتصاد، ولا غالبية المجتمع، من تجارة المخدرات عابرة الحدود، من مثل أفغانستان وسوريا ولبنان؛ إذ إن الكاسبَ هناك فئاتٌ محدودةٌ متورطة. وقد ألحقت تجارة المخدرات الضررَ بالتجارة المشروعة لهذه الدول، وصارت محرومة من معظم أسواق دول الخليج.
ولا تقتصر أخطار هذه التجارة على تدمير شباب المجتمع، وقوته الرئيسية، في الدول المستهدفة، بل تهدّد أمنَ الدولة؛ فهي وراء ظهور العصاباتِ المنظمة، وكذلك التنظيمات الإرهابية. كما أنَّ مهربي المخدرات يقومون بجمع المعلومات، وتهريب السلاح وحمله، وإضعاف السلطات المحلية.
وليس بيننا من يتوهَّم أن تهريب الكبتاغون سيتوقَّف سريعاً؛ فتجار المخدرات ومهربوها لن يعدموا الحيلة، ولن يتوقفوا عن المحاولة... هذه حرب مستمرة.
GMT 10:43 2025 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
جانب فخامة الرئيسGMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
القاهرة ـ مصر اليوم
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الصندوق وافق في اجتماعه التنفيذي اليوم على مراجعة مصر الرابعة وصرف...المزيدنيكول سابا تعود بقوة الى الدراما المصرية من خلال شخصية رقية العسكري في مسلسل "وتقابل حبيب"
القاهرة ـ مصر اليوم
عبّرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها بالعودة الى الدراما المصرية، بعد غياب سنوات، وكشفت عن الأصداء الإيجابية لشخصيتها "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب".وأوضحت سابا في تصريحات صحافية أن شخصي�...المزيدأميركا تتهم 12 صينياً باختراق وكالات حكومية وبكين تندد بجهود تشويه السمعة
واشنطن ـ مصر اليوم
وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى 12 صينياً، بينهم اثنان من مسؤولي الأمن العام، بالتورط في حملة قرصنة استهدفت وكالات حكومية أميركية، فيما نددت بكين بما وصفته بـ"الجهود الأميركية لتشويه سمعة الصين"، بح...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن ـ مصر اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©