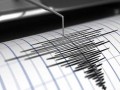الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
السعودية بعد عشرين عامًا

عبد الرحمن الراشد
قراءة المستقبل السعودي ليست ضربا من الخيال، ولا شعوذة، لأن القراءات الحاضرة تنبئ بما قد تكون عليه السعودية بعد عشرين عاما، على الأقل من الناحية التنموية والوضع السياسي. ولنبدأ من قمة الهرم، حيث فريق قيادة الدولة؛ الملك الذي اتخذ صفة الملك الحكيم، لثراء خبرته وكونه أحد أقطاب الحكم السعودي منذ بدايات شبابه. هذه الخبرة الثرية اختارت فريق عمل من الشباب في معظمهم، سواء لولاية العهد أو الوزراء والمستشارين. والعمر الفتي في الإدارة ليس شرطا للإنجاز، إنما يعطي مؤشرا على أن القائد الذي مارس ونجح في إدارة الحكم شابا يريد أن يستنسخ تجاربه؛ فوضع ثقته في مجموعة شبابية، والحقيقة أنها ثقة غالية وتضع حملا ليس بالهين على أكتاف أصحابها؛ فهي ليست مجرد تكريم أو هدية.
أبرز هؤلاء الشباب محمد بن سلمان، ابن الملك، وزير الدفاع، تعرف عليه الناس حين كان ملازما لوالده في إمارة الرياض، ثم عرفوه مستشارا لوزير الدفاع حينما كان والده يحمل حقيبة الدفاع. وهذه الوزارة تحديدا ليست من المؤسسات التي تتلامس مع الجمهور، خاصة في دولة مدنية مثل المملكة، إنما وقد اختاره الملك سلمان رئيسا للديوان الملكي، فهذا يعني أنه في موقع يشابه موقع والده حينما كان أميرا للرياض لخمسة عقود، أي الاحتكاك المباشر بالناس واحتياجاتهم. الأمير محمد يعلم أن نجاحه في منصبه الجديد لا يعتمد على كونه ابن الملك سلمان بن عبد العزيز، فالنجاحات لا تورث، الخصال هي التي تورث، واختياره لمواقع حساسة بالغة الأهمية وهو في هذه السن يعني أن القيادة ترى فيه مقومات النجاح، وقد أحسن صنعا فور توليه رئاسة الديوان الملكي بعمل موقع إلكتروني للديوان لاستقبال مسائل الناس ومظلماتهم؛ أسلوب متطور، بدلا من الحضور والتزاحم أمام بوابة الديوان، كما جرت العادة منذ التاريخ. يمكن الاستنتاج بأن إدارة الحكم الحالية اتخذت الخطوة الأولى في إدخال أحفاد المؤسس الملك عبد العزيز بيت الحكم، يمكننا أن نتخيل أن من يمسك بالمستقبل السعودي هم شريحة شبابية من الأسرة الحاكمة، تتلمذت داخل أروقة الحكم أو برزت في مجالات العمل السياسي أو الاقتصادي.
هذا يجعلني أعرج على أحد أبرز مكونات العمل المؤسسي، مصنع الأفكار والسياسات والتسويق الإعلامي والعلاقات العامة، وهي المراكز البحثية. الحقيقة أني فشلت في محاولة إحصاء عدد مراكز البحوث في أميركا، سواء الخاصة أو التي تتبع المؤسسات الرسمية، كوزارة الخارجية أو الأمن القومي أو وزارة الخزانة، حتى في أوروبا كانت محاولة الرصد عصية، لكثرتها. هذه المراكز تقسم نفسها إداريا وفقا للمناطق الجغرافية حول العالم، تطبخ فيها الرؤى والتوجهات، ولها أهمية كبرى كمرجع لصانع القرار. نستطيع ملاحظة هذا التأثير في الولايات المتحدة، حيث يقود العاملون في هذه المراكز الرأي العام من خلال حضورهم الإعلامي الكبير، والترويج لأفكارهم، وعمل استطلاعات الرأي لفهم أمزجة الناس وتوجهاتهم. السعودية تعتبر أبرز دولة عربية ذات تأثير دولي، وهي أحوج ما تكون لانتهاج هذا الأسلوب المؤسسي، وستنجح فيه لا محالة لأنها لا تروج لبضاعة كاسدة، كما فعلت شركات بشار الأسد للعلاقات العامة، ولا لأفكار وطموحات هدامة، كما تفعل مراكز البحوث الإيرانية في أميركا وبريطانيا.
لدى السعودية كنز لم يُستخرج بعد، وهم الشباب العائدون من برنامج الابتعاث للدراسة في الخارج، وأقول: لم يُستخرج بعد، لأن حصولهم على شهادات أكاديمية لا يعني شيئا بالضرورة، إن لم يستثمر بشكل فعال في صناعة وجوه سياسية، إعلامية واقتصادية، يتم انتخابهم وتدريبهم على يد النجوم السعودية التي لمعت في سماء الإعلام والسياسة، أو من خلال بيوت الخبرة العالمية الموثوقة، ليكونوا بعد عشرين عاما قيادات في مواقعهم، باحثين ومفكرين ومرجعا لصناع القرار. النهج السياسي للمملكة شبه ثابت منذ وضع أسسه الملك عبد العزيز (رحمه الله)؛ علاقات المصلحة مع الدول الصديقة، ومحاولة رأب الصدع مع الأشقاء والجيران، والنفور من مزالق النزاعات والحروب والسخونة الإعلامية، وهذه مبادئ مستقيمة لا تتعارض مع كون العالم يدار اليوم بمنهج إداري يعتمد دراسة معمقة للتحديات، وتحليلا للوقائع، وقراءة متوقعة للمستقبل.
أما على المستوى التنموي، فلا حديث سوى حديث التعليم، أو كما سماه الأستاذ عبد الرحمن الراشد «أم العلل»، إنما في أم العلل ميزة جميلة، وهي أنها مكشوفة ومعروفة. لا أتصور أن أي واحد منا سواء مسؤول أو مواطن عادي لا يعرف مواطن الخلل في التعليم، والوزير الجديد الدكتور عزام الدخيل له رؤية في التعليم مبنية على أسس التعليم في أرقى دول العالم، وقراءة مؤلفه الجميل كتاب «تعلومهم» يشي بكثير من الطموح والانفتاح على الممارسات التعليمية الناجحة، إنما التنظير شيء والواقع شيء آخر. الوزير لديه خياران؛ إما أن يحوم حول العلل دون أن يقع فيها حتى تنتهي مدة توزيره، أو أن يعلق الجرس ويضع يده على الجرح. شخصيا، أعتقد أن الرؤية التي يحملها الدكتور الدخيل في التعليم، والتي تعمقت في نفسه طوال السنوات الماضية، لن تبقيه بعيدا عن خطوات التصحيح والتطوير، الوزير الجديد هو أحد صانعي المستقبل السعودي بعد 20 عاما.
يتبقى الشأن الأبرز، الذي لا يبرح وسائد القلق، وهو المرأة. أين ستكون المرأة السعودية بعد 20 عاما من الآن؟ أين ستكون بعد 20 عاما من دخول مجلس الشورى، وتأهيلها تأهيلا أكاديميا وعلميا رفيعا؟ هل ستكون جزءا من إدارة الحكم، بالتوزير أو التعيينات العليا، كما في الجزء الأول من المقال؟ أم تكون عضوا فاعلا في مراكز البحوث الكبرى، كما في الجزء الثاني من المقال؟ أم ستكتفي بكونها معلمة مدرسة في «أم العلل»، لتكون هي الأخرى علة على الاقتصاد الوطني؟ كلي أمل أن يكون لها مستقبل واعد في هذا العهد الجديد، ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على مدى قناعة صانع القرار بها وبقدراتها.
GMT 08:58 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
سبع ملاحظات على واقعة وسام شعيبGMT 08:47 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
المالك والمستأجر.. بدائل متنوعة للحلGMT 08:43 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
إيران ولبنان.. في انتظار لحظة الحقيقة!GMT 08:40 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
أوهام مغلوطة عن سرطان الثديGMT 07:32 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
ماذا تفعلون في هذي الديار؟GMT 07:31 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
من جديدGMT 07:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
رُمّانة ماجدة الرومي ليست هي السبب!GMT 07:29 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
لقاء أبوظبي والقضايا الصعبة!مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز �...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©