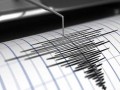الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
حاجتنا إلى الرقص

د. وحيد عبدالمجيد
لا تعرف ثقافتنا الرقص إلا فى أسوأ أشكاله. فقد حوَّلنا الرقص الشرقى من فن إلى إثارة جنسية فابتذلناه ولم نترك مجالاً لتطوره كلون فنى له قواعده ومقوماته. كما عجزنا، إلا فيما قل أو ندر، عن استلهام فلسفة الرقصات التى نتعلمها من ثقافات شعوب أخرى. وحتى موروثنا الصوفى الجميل فى مجال الرقص الذى يعتمد على التأمل الروحى العميق عبر الحركة الدائرية البديعة، والذى يُعد «المولوية» أفضل من يقدمونها، فرَّغناه من مضمونه الروحى العميق.
فقد أطلقنا عليه «التنورة» نسبة إلى اللباس الذى يُرتدى خلال طقوسه واختزلناه بالتالى فى الشكل الخارجى بعيداً عن محتواه الروحى0 كما نشاهده بدون أى تفاعل معه ليس فقط لأننا لا نعرف ماهيته، ولكن أيضاً لأن الخواء الروحى السائد فى المجتمع لا يترك مجالاً لمثل هذه المعرفة.
فقد وصل انتشار الكراهية فى المجتمع إلى مستوى خطير، وتغلغل الانقسام السياسى الذى بلغ ذروة غير مسبوقة فى قلب هذا المجتمع، وأصبح قتل بعضنا البعض أمراً عادياً. ولذلك صار الرقص على الجثث هو النوع الأكثر شيوعاً من الرقص فى مجتمع لا يمر يوم بدون دم فيه.
وفى مثل هذه الحالة، التى تجعل أرواحنا خاوية كما لم تكن فى أى وقت مضى، تشتد حاجتنا إلى التفاعل مع الرقص الذى يضع حداً لهذا الخواء سواء ما هو موجود منه فى تراثنا الصوفى، أو ما نتعلمه من شعوب أخرى ساهمت رقصات مشهورة لديها فى تحسين حياتها مثل كثير من الرقصات اللاتينية المنتشرة فى أمريكا الجنوبية، أو حتى فى تخفيف آلامها وأحزانها حيث تبرز فى هذا المجال رقصة «التانجو» الأرجنتينية المشهورة عالمياً التى لم يصل إلينا منها إلا حركاتها الإيقاعية.
لقد وُصفت «التانجو» بأنها رقصة الأفكار الحزينة، أو طقس الأحزان الراقصة. كما وُصفت موسيقاها المميزة بأنها نوع من التأمل الفنى فى أحوال بائسة. ولكن هذا التعبير عن الحزن والبؤس، والذى تشتد حاجتنا إليه اليوم، يساهم فى تخفيف آلامهما. فأشد حالات الحزن والبؤس وأكثرها إيلاماً هى تلك التى ترتبط بخواء الروح على نحو يجعل الإنسان كارهاً نفسه بمقدار ما يكره الآخر المختلف معه ويتمنى زواله من الوجود.
ولعل هذا يفسر التغير الذى حدث فى نوع الأغانى المصاحبة لهذا النوع من الرقص على مدى تاريخه، كما فى الشرائح الاجتماعية التى أقبلت عليه خلال هذا التاريخ الذى يمتد إلى نحو قرن ونصف من الزمن.
GMT 08:58 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
سبع ملاحظات على واقعة وسام شعيبGMT 08:47 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
المالك والمستأجر.. بدائل متنوعة للحلGMT 08:43 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
إيران ولبنان.. في انتظار لحظة الحقيقة!GMT 08:40 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
أوهام مغلوطة عن سرطان الثديGMT 07:32 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
ماذا تفعلون في هذي الديار؟GMT 07:31 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
من جديدGMT 07:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
رُمّانة ماجدة الرومي ليست هي السبب!GMT 07:29 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
لقاء أبوظبي والقضايا الصعبة!مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز �...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©