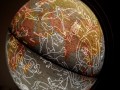الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
الثقافة العلمية وإعداد النشء العربى للمستقبل (3- 3)

بقلم - عمار علي حسن
تناولت فى مقالى الأسبوعين الماضيين مشكلة ضعف الثقافة العلمية لدى النشء، وحددت ثلاثة سبل للمواجهة، وهى: التعليم والثقافة والمجتمع المدنى، وهنا أكمل:
4- العلماء والأدباء: فلأهل العلم دور كبير فى هذه المسألة حين لا يكتفون كلهم أو بعضهم بالعزلة فى المختبرات، إنما يؤدون ما عليهم من مسؤولية حيال أجيال صغيرة، من المهم أن نجعل الانشغال بالعلم جاذبًا لهم ومحرزًا، من خلال تقديم رموز اجتماعية كبيرة من بين العلماء، وإظهار ما يقدمه أغلبهم من خير للبشرية، وهذا لن يتحقق بالفعل إلا من خلال تشجيع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلام، لكن هذه الأطراف لن تقوم بهذه المهمة إلا بضغط أو حض متواصل من العلماء، خاصة فى ظل أعمال فنية، يتم إنتاجها فى كثير من دول العالم الثالث، تحط من شأن العلماء، وتظهرهم وكأنهم بشر بلا مشاعر أو آلات من لحم أو أناس يعانون سذاجة اجتماعية.
أما بالنسبة للعلوم الإنسانية، فإن مسار الدراسات المستقبلية، الذى يستوى على سوقه ويحفر لنفسه مكانًا فى حقول المعرفة، يجب أن يكون ضمن المساقات الدراسية التى نعلمها لأطفالنا، منذ نعومة أظافرهم، لكن بطريقة مبسطة، تراعى كل مرحلة عمرية، بحيث لا تغيب عن أى مرحلة، ويكون هذا الأمر ليس أحد اهتمامات واختصاصات واضعى المناهج الدراسية فقط، إنما أيضًا العلماء المهتمين بهذا النوع من الدراسات.
فى الوقت نفسه، يجب أن يلعب الأدباء أيضًا دورًا على هذا الدرب من خلال أدب الخيال العلمى، إذ لا يمكن النظر إلى المستقبل إلا بعيون متخيلة، فمهما بلغت قدرتنا على فهم حاضرنا، ووضع الخطط التى تنقلنا إلى ما هو آتٍ فى تمكن واقتدار، فإن هذا إن لم يكن فى ركاب الخيال فمحكوم عليه بالتراجع. وهذا مسار لا يتعلمه الناس فى الكبر، إنما يجب أن يُنقش أو يُحفر فى عقول الصغار ليبقى أثره. وهنا يأتى دور أدب الخيال العلمى كإحدى الروافع المهمة فى هذا الاتجاه، فهو، ولأنه أدب، يمثل أقصر الطرق إلى تحقيق هذا الهدف لأنه لا يقدم قيم التقدم بشكل مباشر، فى وعظ جاف أو عبر رطانة تتبدد بمرور الوقت، إنما من خلال سرد جاذب وماتع، يقوم بتسريب وترسيب قيم التفكير العلمى على مهل، ويجعل متلقيها ينحازون إليها طواعية، وليس إجبارًا أو قسرًا.
5- التأثر: لا يمكن للثقافة العلمية للنشء فى مجتمعاتنا أن تتبلور وتمضى بمعزل عن الحياة المعاصرة، التى امتلكت من الإمكانات والأدوات والطموحات ما يتعدى كثيرًا الموجودات المحلية، بصورها القديمة أو المتاحة، الواقرة فى أذهان ما قبل ثورة الاتصالات، التى حولت العالم إلى غرفة صغيرة، بل مقعد واحد فى أى مقهى، يجلس عليه شاب يمسك بيده هاتفًا فائق الذكاء، فالآن، وبفضل هذا التطور الرهيب، لا يمكن لحياتنا هنا أن تنعزل عما يجرى فى العالم حولنا، فتقنيات التفاعل الإلكترونى اللامحدودة، وخاصة وفق «مواقع التواصل الاجتماعى»، فتحت نوافذ عديدة أمام صغارنا ليتفاعلوا مع أقرانهم وما هم أكبر منهم، فى مجتمعات أخرى، فطنت إلى تعزيز النظر إلى ثقافة المستقبل فى أذهان ووجدان أطفالهم.
إن هذا التفاعل بلغ حدًّا بعيدًا من الانتشار والنفاذية، وأزاح من طريقه الكثير من الأفكار والتصورات والقيم التى عششت فى رؤوس جيل ما قبل ثورة الاتصالات، وملأت كل الفراغات التى كان من الطبيعى أن تقوم بين ما نحن عليه وبين ما وصل إليه العالم من حولنا.
لذا لم يعد الأمر أمام مجتمعاتنا الآن هو تجاهل المستقبل أم الاعتراف به والامتثال له، إنما كيفية أن يُدار التفكير فيه، وكل ما ينجم عن هذا التفكير من تدابير، بما يحقق مصلحة مجتمعاتنا، وهذا لا يمكن أن يتم على وجه أكمل إلا بإعداد النشء لثقافة علمية إيجابية، ليس أمامها حدود.
ومن دون شك فإن أول مدماك فى هذا البناء، الذى يجب أن يُقام شامخًا راسخًا، هو ذلك الذى يجعل صغارنا يستخدمون التقنية الحديثة فى التواصل، وفى تحصيل المعرفة والعلم، وليس فى التسلية البحتة، والإغراق فى النميمة، والأخبار العابرة التافهة، كما نرى الآن، جهارًا نهارًا.
GMT 10:43 2025 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
جانب فخامة الرئيسGMT 10:17 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
ممدوح عباس!GMT 10:15 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
القديم والجديد؟!GMT 08:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
فرنسا تتصالح مع نفسها في المغربGMT 03:37 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حزب المحافظين البريطاني: «لليمين دُرْ»!ترامب يصعّد ضد سيول ويرفع الرسوم على سلع كوريا الجنوبية
واشنطن - مصر اليوم
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على سلع كورية جنوبية مختلفة، منتقداً سيول لعدم التزامها باتفاقية تجارية سابقة أبرمتها مع واشنطن. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بما...المزيدماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
القاهرة ـ مصر اليوم
حلّت الفنانة ماغي بوغصن ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن رؤيتها للوسط الفني، مميزاته وتحدياته، مؤكدةً أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - مصر اليوم
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدمجمع الملك فهد يوزع مصحف المدينة للمكفوفين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الرياض ـ مصر اليوم
وزّع جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلًا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026م، في دورته السابعة والخمسين، مصحف المدينة النبوية ال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©