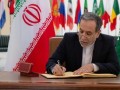الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
يريدونها «كوريا الشمالية».. لكن هيهات فمصر مختلفة

بقلم : عمار علي حسن
(1)
قبل خمسة عشر عاما، وبينما كان صدام حسين يحكم العراق، سألت صديقا عراقيا عاش ربع قرن فى بريطانيا وحصل هناك على الدكتوراه فى الاقتصاد: أتعرف ما الفرق بين مصر والعراق؟ هز رأسه ورد على سؤالى بسؤال: ما هو؟ أجبته: يمكن لصدام أن يربط أكبر مثقف فى العراق فى عمود كهرباء أو نخلة بقلب ميدان الفردوس، ولا يجرؤ أحد على فك قيوده، بل قد يطلب من العابرين أن يبصقوا عليه، أو يرموه بأحذيتهم، حتى يلقى حتفه، وسيفعلون طائعين. أما فى مصر فلا يجرؤ حسنى مبارك على فعلها، وهو إن أراد أن ينكل بأحد فإما يختلق له جريمة أو جنحة أو يلفق له تهمة ويدفع به إلى السجن عبر القضاء، أو يأمر بخطفه فى الليل البهيم ليتم التخلص منه بعيدا عن أعين الناس، ثم لا يجاهر بهذا أبدا.
وسألنى: لماذا مصر على هذا النحو؟ فأجبته أن المجتمع المصرى ظل طيلة التاريخ موجودا، لا يستطيع أى حاكم مهما ركبته أوهام الغرور والتكبر والتجبر أن يتجاهله. كما أن المصريين اعتادوا أن يدبروا شؤونهم بغض النظر عمن يحكمهم، وطالما تعاقب على عرش بلادهم مستبدون وبلهاء ومرضى نفسيون وعديمو خبرة وخاطفو سلطة، لكن هؤلاء لم ينالوا من الناس إلا بالقدر الذى سمح لهم الناس بهم، وكثيرون منهم ظلوا معزولين، يلهون بسلطة فارغة، والشعب يسخر منهم بنكات لاذعة، ثم يلقيهم فى سلة مهملات التاريخ، بلا ذكر ولا استدعاء، ولاسيما أولئك الذين خدعوا الشعب وكذبوا عليه وظنوا أنهم أذكى من الجميع، مع أن تخطيطهم وتدبيرهم مفضوح، ولا يزيد على كونه حبلا سيشنقون به أنفسهم فى النهاية.
هذه مقدمة ضرورية لنتيجة نراها الآن، وهى أن هناك الآن من يريد لمصر أن تكون «كوريا الشمالية»، حيث نرى فى بلادنا تكميم الأفواه، والضيق بكلمة معارضة، وملاحقة المختلفين مع السلطة إما بتلفيق اتهامات أو تشويه صورة من خلال أبواق إعلام غارق فى العار، أو عبر تفجير الأحزاب من داخلها بواسطة عملاء الأمن ووسطائه، أو يسن قوانين ترمى إلى أن يدخل الجميع، صحفيين وقضاة ومحامين وأطباء، بيت الطاعة، ويصير البرلمان مجرد هيكل خشبى هش تصفر فيه الريح، فى ظل النفخ فى أوصال فكرة المؤامرة ليعيش الكل حالة من الذعر، ويصيروا أمة من الأغنام، يسلمون قيادهم تماما للحاكم وأعوانه، وسط تصور ساذج بأن المجتمع كله يجب أن يفكر بطريقة واحدة، ويتكلم الحروف نفسها، ويتصرف التدابير ذاتها، بدعوى أن هذا هو المطلوب.
مثل هذه الإرادة تقوم على وهم وأمنية مخيفة عابرة ساذجة بأن مصر يجب أن تكون كوريا الشمالية- طبعا بلا قدرات عسكرية فائقة وقدرة على التحدى والتصدى- فهذا هو المطلوب والمرغوب، لكن هيهات، فنحن مختلفون جدا جدا، وعما قريب ستعلم السلطة، التى لم تتعلم الدرس، أنها أساءت التقدير والتصرف.
(2)
فى عام 1994، وكنت أول عهدى بالبحث فى الاجتماع السياسى، قدمت دراسة إلى ندوة كان عنوانها «أوجه الشبه والاختلاف بين جماعات الإسلام السياسى»، ذكرت فيها ملاحظة حول انتماء أغلب قيادات تنظيمات «الجماعة الإسلامية» و«الجهاد» و«الإخوان» إلى الكليات العملية، خصوصا «الطب» و«الهندسة»، وطرحت سؤالا يومها عن الأسباب التى تؤدى إلى هذا المسار، لكن الإجابات لم تأت شافية كافية.
ولم ينشغل كثيرون بهذه المسألة من الأساس، رغم أنها تستحق العناية والرعاية، حتى جاءت صحيفة «جارديان» لتتحدث عن طلبة الكليات العملية فى تنظيم «داعش»، وهنا انتفضت الصحف العربية نشرا للموضوع فى إعجاب، وتعليقا عليه بشهية مفتوحة، ثم انقضى الأمر، كأننا قرأنا خبرا طريفا.
وقد انتهزت فرصة المشاركة بمحاضرة عن «الشخصية المصرية» فى سياق مؤتمر عن المجتمع والصحة العامة فى مصر عقدته كلية الطب جامعة الإسكندرية أواخر شهر نوفمبر الماضى، وطلبت من رئيسة الجامعة التى كانت تجلس إلى جوارى على المنصة أن تبدأ فى تطبيق هذا المسار، بواقع مادة واحدة كل سنة دراسية، لتكون لجامعة الإسكندرية الريادة، وبعدها ستحذو جامعات أخرى حذوها. وأكرر الأمر نفسه الآن بمناسبة ما جرى خلال جلسة للجنة التعليم بالبرلمان قبل أيام. بل أقوله دوما لأنه مطبق فى جامعات الدول المتقدمة، ليس لمقاومة التطرف الدينى أو الأيديولوجى، إنما لأنه يفيد عملية التعليم ويساعد على تكاملها وتعميق القدرة على الابتكار والإحاطة فيها.
ليس معنى هذا أن الكليات التى تدرس العلوم الإنسانية لم تنتج متطرفين إنما الأمر فى الكليات العملية أكثر ظهورا ورسوخا. وهذا أمر يجب ألا يُترك سدى، وبلا جدوى، إنما من الضرورى أن يُدرس على وجه دقيق، لنقف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة الممتدة فى حياة العرب والمسلمين. ولا يكفى هنا أن تجمع أجهزة الأمن المعلومات عن خريجى وطلاب الكليات العملية المنتمين إلى جماعات «الإسلام السياسى» وتقول «نعرف كل شىء عنهم»، فليس هذا هو المقصود، إنما كيف يمكن أن ننقذ هؤلاء الطلبة، ومنذ البداية، من الانسياق وراء التطرف الدينى، بطرق أعمق وأشمل من مجرد المواجهة الأمنية؟
إن الإجابة عن السؤال السابق تتطلب أولا عرض الأسباب التى تؤدى إلى غلبة نسبة المنحدرين من التعليم التطبيقى أو البحت على أعضاء الجماعات والتنظيمات التى توظف الدين الإسلامى فى تحصيل السلطة السياسية وحيازة الثروة الاقتصادية، وهى فى الحقيقة أسباب معقدة ومتشعبة، لكن يمكن ذكرها باختصار فى نقاط محددة، أولاها أن هذه الكليات، خصوصا الطب والهندسة، تركز عليها هذه الجماعات فى عملية التجنيد فى صفوف الطلبة كى تستثمر الخريجين فيما بعد اقتصاديا واجتماعيا. فجماعة الإخوان، مثلا، تفتح للأطباء الجدد منهم عيادات ومستوصفات تدر على الجماعة دخلا وفيرا، وتمكن الأطباء من بناء رصيد اجتماعى من خلال التعامل اليومى مع المرضى، وتخصيص ساعة فى اليوم أو يوم فى الأسبوع للفحص المجانى، فإن زاد هذا الرصيد عند بعض الأعضاء دفعتهم الجماعة إلى الترشح فى الانتخابات التشريعية، وهى تعرف قدرتهم على المنافسة.
وتضمن الجماعة أن يتحقق هذا بسهولة نظرا للمكانة الاجتماعية التى يحظى بها الطبيب والمهندس بين الناس، لاسيما البسطاء منهم، ونظرا للإمكانات المادية الكبيرة التى تضعها قيادة الإخوان فى أيدى هؤلاء، الذين يشكلون عنصراً مهماً من عناصر صناعة العمق الاجتماعى لها، عبر تقديم الخدمات الصحية حين تعجز أو تضعف قدرة الدولة على تقديمها.
والعامل الثانى هو أن الدراسات العملية تقوم على قوانين علمية محددة، وبهذا فهى لا تمنح صاحبها قدرة على المساءلة والجدل يؤتيها خريجو الكليات الإنسانية أو النظرية، وبالتالى يصبح طالب الكليات العملية مثاليا لجماعة تقوم على السمع والطاعة. وهذا العيب يتعمق فى الحقيقة مع غلبة الحفظ على الفهم فى نظمنا التعليمية فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فيصبح الطالب حين يصل إلى الجامعة صيدا سهلا لهذه الجماعات، التى تحتاج إلى عقول منغلقة لم تتعلم الشك فيما تسمع وتقرأ، ولا تُسائل كل ما يجرى حولها وأمامها، ولا تأخذ كل شىء على أنه نسبى.
والعامل الثالث هو أن دارسى العلوم التطبيقية يعتقدون أن العالم والمجتمع يسير على شاكلة الأرقام والنظريات والقوانين العلمية الصارمة، بما يجعلهم غير مؤمنين بالتعددية واختلاف الآراء والتوجهات وتباين المصالح، فالحقيقة العلمية واحدة، وهو أمر يريده الإخوان وأتباعهم ممن يزعمون أن ما هم عليه هو الحقيقة، وهو واحد لا يقبل التعدد، لأنه «صحيح الدين» و«الطريق المستقيم» و«نهج الصحابة» وهذه الأقاويل غير العلمية تنطلى على كثيرين، من أسف شديد.
والعامل الرابع يتعلق بجفاف الدراسات التطبيقية مما يجعل الدارسين فى حاجة إلى ما يروى ظمأهم الروحى، وهنا تطرح الجماعات الإسلامية المسيسة تصورها لهم باعتباره الدين، وتضمن إقبالا شديدا منهم عليه.
GMT 01:14 2023 الإثنين ,17 تموز / يوليو
انفجرت الحقيبة وغيَّرت وجه اليمنGMT 02:31 2023 الجمعة ,09 حزيران / يونيو
العراق وطهران... أوهامGMT 00:13 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير
قاسم سليماني... لُب الخمينيةGMT 00:01 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير
جثة صدّام أمام منزل المالكيGMT 02:33 2022 الجمعة ,26 آب / أغسطس
إيران تناقش مسألة القنبلة"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©