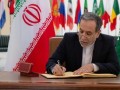الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
قديم لا يغادر وجديد لمّا يأت بعد

بقلم عريب الرنتاوي
لا رهانات فلسطينية على مؤتمر باريس الدولي المقرر التئامه قبل انتهاء موسم الأعياد … الرهان الفلسطيني ينعقد في مكان آخر: اعترافات أوروبية لاحقة بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بعد أن تنجلي للعالم، صورة إسرائيل بوصفها الطرف المعرقل لمسارات التفاوض وحل الدولتين.
بالمعنى السياسي والدبلوماسي، لا غبار على المقاربة إن لم يترتب عليها دفع أثمان إضافية، فكثير من المعارك التي يخوضوها الفلسطينيون والإسرائيليون منذ سنوات، هي معارك حول “الصورة”، الصورة التي يرغب كل فريق بأن يظهر فيها وعليها، مقابل صورة أخرى، نقيضة، يسعى في إلصاقها بالطرف الآخر … بهذا المعنى، تبدو معركة مؤتمر باريس، وقد حسمت لصالح الفلسطينيين، بعد أن أظهر نتنياهو وفريقه الحكومي، فائضاً من التعنت والصلف، يملي على أوروبا، الوفاء بالتزاماتها المعلنة والمضمرة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية العتيدة.
لكن في المقابل، يخطئ الفلسطينيون إن هم ظنوا، أن حصاد معارك الصورة والرواية هذه، يمكنها أن تقرب موعدهم مع الحرية والاستقلال … فهذا النوع من المعارك، وبالذات في حالة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تظل من النوع “الثانوي” الذي لا يكفي وحده، لإحداث تعديل جدي في موازين القوى وتوازناتها، أو يفضي إلى رفع كلفة الاحتلال بالقدر الذي يسمح بتسريع رحيله … على أهمية هذه المعارك، لا يجوز لأحد، أن ينام على حرير إنجازاتها وانتصاراتها.
ذلك أن إسرائيل، لم تعد تقيم، وهي لم تُقم من قبل، وزناً حقيقياً لهذه المعطيات والاعتبارات، اليوم تخضع إسرائيل لحكم ترويكا يمينية، تعتقد أن توسيع مستوطنة أو بناء بؤرة استيطانية جديدة أو تشريع أخرى، أهم بكثير من استرضاء السيد فرانسوا هولاند، أو جعل حياة أوباما – كيري أكثر سعادة … بدلالة أن إسرائيل، اختارت توقيتاً عجيباً لتمرير مشروع قانون لـ “شرعنة” البؤر الاستيطانية، من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار توقيتات مؤتمر باريس أو التصريحات الغاضبة للسيد جون كيري في معهد بروكينغز.
والأرجح أن شهية إسرائيل التوسعية التي تفتحت أكثر من أي وقت مضى على وقع التصريحات الرعناء للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي خرجت عن مألوف الخطاب الرسمي الأمريكي بخصوص الاستيطان، سوف تلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين وحقوقهم في قادمات الأيام، وربما بخطى متسارعة ومشاريع عملاقة، طالما أن الاستيطان من منظور السيد الجديد للبيت الأبيض، ليس عقبة في طريق السلام وحل الدولتين.
وقد ينتهي الحال بالفلسطينيين إلى وضعية هي الأشد غرابة في تاريخ حركات الاستقلال والتحرر الوطني … إذ كلما تزايد الاعتراف العالمي بحقهم في دولة مستقلة وقابلة للحياة، بعد الخلاص من نير الاحتلال، كلما بات تجسيد هذه الدولة أمراً متعذراً، أو حتى مستحيلاً من الناحية العملية … ولا أدري بعد ذلك، كيف يمكن للفلسطينيين التصرف بكل هذا “الرصيد” من الاعترافات الدولية، وكيف يمكن تجييره معركتهم من أجل تقرير المصير، وهل هو من النوع الذي سيبقى ويتعاظم، أم أنه من النوع “سريع النفاذ” بالتقادم أو عند أول مبادرة منقوصة لفرض حلول غير مرغوب بها على الفلسطينيين؟
لا شك أن تفهم العالم وتأييده لحقوق الفلسطينيين العادلة والمشروعة، أمر في غاية الأهمية، فالفلسطينيون ليسوا وحدهم في هذا الإقليم أو على الساحة الدولية … لكن التفهم والاعتراف وحدهما ليسا بكافيين تماماً لإنهاء الاحتلال الجاثم على صدورهم، والحاجة تبدو ماسة أكثر من أي وقت، لبذل مزيد من الجهود وتوظيف الكثير من الطاقات، على مسارات أخرى، لعل أهمها على الإطلاق، اجتراح معادلة تكفل تعزيز صمود الفلسطينيين في وطنهم وترفع كلفة الاحتلال في الوقت ذاته، وإذ أدرك الفلسطينيون متأخرين، أن النكبة لم تكن بضياع الأرض بل بهجرة سكانها، فإن أية توافقات بشأن أشكال الكفاح وأدواته في المرحلة المقبلة، يجب أن تلحظ شقي هذه المعادلة، وأن تلحظهما معاً، فإي “تطرف” بالانحياز لشق من المعادلة على حساب الشق الآخر، سيفضي إما لانتهاج سياسات مستكينة، خانعة للاحتلال ومتعايشة معه، أو إلى مجازفات ومغامرات، لا يبدو الشعب الفلسطيني، ولا البيئة الإقليمية من حولة، بقادرين على تحمل أعبائها وتبعاتها.
ومن يتابع الجدل الوطني الفلسطيني الداخلي، الفصائل والشعبي عموماً، يلحظ أن ثمة “مستودعاً” من الأفكار والمبادرات التي يمكن الأخذ بها والاتكاء عليها، بيد أن السؤال الذي لم يجد جوابه بعد، يتعلق بقدرة البنى المؤسسية الفلسطينية، بما فيها البنى الفصائلية ومؤسسات المجتمع المدني والأطر التقليدية، ما زالت قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الاستراتيجية التي تجتازها الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، أما أن المجتمع الفلسطيني ما زل يمر بمرحلة الانتقالية صعبة للغاية، تتلخص في “قديم يرفض المغادرة” و”جديد لم يتبلور بعد”.
GMT 15:16 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس
مَنْ ينبش كوابيس الفتنة ؟!!GMT 06:13 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر
تحوّل استراتيجيGMT 08:20 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر
من هنري كيسنجر إلى آفي بيركوفيتشGMT 07:53 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو
رسائل البغدادي المفتوحة و«المشفّرة»GMT 06:44 2019 الخميس ,02 أيار / مايو
واشنطن و «الاخوان»صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقًا مع مصر يمهّد لصرف 1.2 مليار دولار
القاهرة ـ مصر اليوم
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، مما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج. أزمة اقتصادية مستمرة ف...المزيدهيفاء وهبي تعوض غيابها عن دراما رمضان 2025 بثلاثة أعمال جديدة تجمع بين السينما والدراما
القاهرة ـ مصر اليوم
هيفاء وهبي تركز بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، على تأكيد حضورها كممثلة في أكثر من عمل، واستطاعت النجمة اللبنانية أن تختار أكثر من تجربة تخوضها على المستوى الدرامي والسينمائي، لاسيما بعد الإعلان عن استعدادها لخوض �...المزيدالبيت الأبيض يكشف عن اختراق شركة اتصالات أميركية في حملة تجسس صينية ضخمة
واشنطن ـ مصر اليوم
قالت مسؤولة بارزة في البيت الأبيض، اليوم، إنه تم التأكد من تعرض شركة اتصالات أميركية تاسعة للاختراق في إطار حملة تجسس صينية ضخمة أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى نصوص خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمي�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيدرونالدو يصرح بأن فينيسيوس تعرض للظلم في جائزة الكرة الذهبية ويثني على عدالة جوائز غلوب سوكر
الرياض ـ مصر اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©