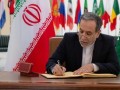الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
«مناغشة» مع الزملاء حول الدولة المدنية ومواطنة المسيحي

بقلم عريب الرنتاوي
سبقني زميلان من “الدستور”، تتجاور زاويتي اليومية بزاويتيهما، إلى تناول ما كنت عزمت على تناوله من عناوين، تصدرت الجدل الوطني العام، في ضوء حادثة مفجعة واستحقاق وطني ... أما الحادثة، فهي اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر، وأما الاستحقاق، فهو الانتخابات النيابية التي جرت وفقاً لقانون النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر والمحافظات، الذي خلق ديناميكيات جديدة في حياتنا السياسية والاجتماعية والحزبية، علينا تتبعها عن كثب، بالبحث والتحليل.
ولقد آثرت أن أخرج عن “قاعدة” درج عليها كثيرٌ من كتاب الأعمدة والزوايا (وأحيانا التكايا) بتجاهل بعضهم بعضاً، حتى حين يقدم بعضهم على إعادة إنتاج وصياغة مقالات لغيرهم، فينجحون أحياناً في الإفلات بفعلتهم، وتفلت من بين أصابعهم وأقلامهم (كيبورداتهم على تعبير أمجد ناصر)، عبارات وجمل، ليست من صنعهم، ومن دون أية حاجة من أي نوع، للإشارة للمصدر.
ما علينا (وهذه محفوظة لمحمد خروب)
عمر كلاب تحدث عن الضلال والتضليل في استخدام مصطلح “الدولة المدنية”، ومن قبل مختلف التيارات السياسية والفكرية في البلاد، ومن دون حاجة لـ “كسوة” المصطلح باللحم والشحم والدم، فنبدو أمام إجماع مضلل، نعجز معه عن فهم أسباب التوتر والاستقطاب والتباعد والتراشق بالاتهامات والتهديدات أحياناً ... كلاب رأى أن التيار الإسلامي جنح لهذا المصطلح تحت ضغوط “الانتخابات” وربما – والكلام من عندي – للتورية والتمويه والتعمية على جوهر مواقفه، وهي في كل الأحوال – والترجيح له – انحناءة تكتيكية.
لا أختلف مع عمر حول هذه المسألة، وإن كنت أبقي الباب “موارباً” أمام احتمال هبوب رياح المدنية إلى خطاب هذا التيار الديني، ولدينا نماذج في دول قريبة وبعيدة دالّة على غلبة خيار كهذا، ولدينا مؤشرات من واقع الحركة الإسلامية الأردنية، لا تغلق الباب بإحكام، في وجه احتمال كهذا.
لكنني أختلف معه في بحثه عن أسباب لجوء التيارات العلمانية من يسارية وقومية وليبرالية، إلى التورية والتمويه كذلك، وإشهارها لشعار الدولة المدنية... هو– عمر - رأى أنه “تكتيك” يستهدف استقطاب خصوم التيار الإسلامي، وأنا أرى أنه تعبير عن التردد والجبن في تسمية الأشياء والمواقف بأسمائها الحقيقية، وخشية من مواجهة حملات التهويل والابتزاز والتخويف والتخوين والتكفير، كتلك التي تعرضت لها المناهج المعدلة، برغم محدودية التعديلات التي طرأت عليها، أصحاب الدولة المدنية من العلمانيين، لم يكونوا يعمدون إلى إخفاء هويتهم العلمانية في سنين خلت، فما الذي جرى وألجأهم إلى التمويه والتورية؟ هذا موضوع بحث آخر.
وأخلص إلى محاولة تسمية الأشياء بأسمائها، وكما قلت في مقالة الأمس عن الضجة المفتعلة حول المناهج، فالدولة المدنية، ليست نقيض الدولة العميقة، من أمنية وعسكرية وبيروقراطية فحسب، بل هي نقيض الدولة الدينية كذلك ... والدولة لكي تكون مدنية حقاً، عليها أن تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها ومواطناتها، والدولة حين يجري “تديينها”، تفقد طابعها المدني، وتؤسس لدرجات متفاوتة من المواطنة، تتفاوت هذه الدرجات من تجربة إلى أخرى، بيد أنها تبقى ماثلة في الحقوق المدنية والسياسية والإرث وغير ما هنالك ... ولا أعرف كيف لدولة أن تكون مدنية، فيما القائمون عليها، يعملون على تطبيق الشريعة، سواء أكانت إسلامية أم مسيحية أم يهودية ... والدولة المدنية، تنهض على عقد اجتماعي، محوره المواطنة المتساوية والفاعلة، وهي حداثية بمضمونها، ولا تقوم على البنى والروابط السابقة لنشوء الدول، من عائلية وحمائلية وعشائرية، دولة المؤسسات والقانون السيد، التي لا تعترف بسيادة أي قانون آخر على أرضها .... الدولة المدنية علمانية بامتياز، وبخلاف ذلك، تدخل المواقف والتفسيرات والتحليلات، إما في سياق المجاملة والمداهنة والتضليل، أو في سياق الانتهازية والتورية، أو في سياق التكيف السلبي والانحناءات التكتيكة – وربما الاستراتيجية – مع لغة التهويل والابتزاز، التخوين والتكفير، التي تقيم تماثلاً مقصوداً بين العلمانية والإلحاد أو العداء للدين، وأقول مقصوداً، لأنه يراد به “شيطنة العلمانية والعلمانيين” وتحويلهم إلى حفنة من الزنادقة و”الخوراج” و”كفار قريش”، مع أن أي بحث متسرع ومتكاسل على “غوغل” يظهر المعنى الدقيق للعلمانية ومدارسها المختلفة.
وأخرج من حكاية “الدولة المدنية” إلى حكاية أخرى، وردت في مقالة للزميل العزيز نزيه القسوس، المعنونة بـ “أنا مسيحي ولكن ثقافتي إسلامية”، وفيها يعرض لتجربة أردنية جميلة في العيش المشترك والاندماج بأحلى صوره بين مختلف مكونات شعبنا ومجتمعنا ... وهنا أحييه على ما أورده وما قاله.
لكنني أود أن أعرض لأمرين اثنين، أولهما بإيجاز، أننا نتحول من مجتمع “السماحة” ولا أقول “التسامح” و”العيش المشترك” ولا أقول “التعايش”– وهذا من باب ضبط المصطلحات والمفاهيم كما اقترح عمر كلاب - إلى مجتمع أكثر ميلاً للتطرف والإلغاء والإقصاء والتصنيف والتنميط، إلى مجتمع تحركه هوياته الثانوية وتتهدد وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، بدلالة “حفلة الجنون” التي أعقبت اغتيال ناهض حتر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ننام على حرير الماضي الجميل، طالما أن من بيننا من يجادل ويفتي بعدم جواز السلام على المسيحي، أو تهنئته بأعياده، ويستكثر نشر صورة لكنيسة في كتاب مدرسي وغير ذلك مما تعرف ونعرف ويعرف الناس كافة.
والثاني، أن “مواطنة المسيحي” في بلدنا، ومن حيث المبدأ، تحتمل “النعم” وترفض الـ “لكن” ... فالمسيحي مواطن بهويته وثقافته، وقيمته مستمدة من ذاته، وليس من إعادة تشكيله وإنتاجه على صورة المسلم .... ولطالما خضنا في نقاشات مع بعض إسلاميي بلادنا، الذين ما أن تعرض عليهم فكرة “مواطنة المسيحي” حتى يخرج عليك أولا بالـ “لكن”، ويطالعك ثانياً، حين يحتدم النقاش، بالقول إنهم مسيحيون بيد أن ثقافتهم إسلامية ويسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء الصحابة الأجلاء، لكأن المسيحي وفقاً لهذه المقاربة، لا يستحق مواطنته، إلا بقدر تمثله لثقافة الآخر الديني (الأغلبية)، وأخشى أننا بتنا نجاري هذه المدرسة في التفكير، التي وإن كشف ظاهرها عن “استعداد” للتعامل مع التعددية الأردنية واحترامها، إلا أن باطنها يخفي ضيقاً بهذه التعددية، ومحاولة لإعادة انتاج الآخر الديني على صورة وشاكلة الأغلبية السائدة... مواطنة المسيحي غير مشروطة، سواء أكان اسمه جورج وبول ودانيال أو كان اسمه مصطفى وعمر وجهاد.
GMT 15:16 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس
مَنْ ينبش كوابيس الفتنة ؟!!GMT 06:13 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر
تحوّل استراتيجيGMT 08:20 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر
من هنري كيسنجر إلى آفي بيركوفيتشGMT 07:53 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو
رسائل البغدادي المفتوحة و«المشفّرة»GMT 06:44 2019 الخميس ,02 أيار / مايو
واشنطن و «الاخوان»صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقًا مع مصر يمهّد لصرف 1.2 مليار دولار
القاهرة ـ مصر اليوم
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، مما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج. أزمة اقتصادية مستمرة ف...المزيدهيفاء وهبي تعوض غيابها عن دراما رمضان 2025 بثلاثة أعمال جديدة تجمع بين السينما والدراما
القاهرة ـ مصر اليوم
هيفاء وهبي تركز بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، على تأكيد حضورها كممثلة في أكثر من عمل، واستطاعت النجمة اللبنانية أن تختار أكثر من تجربة تخوضها على المستوى الدرامي والسينمائي، لاسيما بعد الإعلان عن استعدادها لخوض �...المزيدالبيت الأبيض يكشف عن اختراق شركة اتصالات أميركية في حملة تجسس صينية ضخمة
واشنطن ـ مصر اليوم
قالت مسؤولة بارزة في البيت الأبيض، اليوم، إنه تم التأكد من تعرض شركة اتصالات أميركية تاسعة للاختراق في إطار حملة تجسس صينية ضخمة أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى نصوص خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمي�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيدرونالدو يصرح بأن فينيسيوس تعرض للظلم في جائزة الكرة الذهبية ويثني على عدالة جوائز غلوب سوكر
الرياض ـ مصر اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©