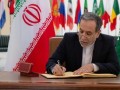الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
معاركنا الفكرية (1-2)

عمار علي حسن
ونحن على أبواب معركة فكرية واجبة وضرورية مع جماعة الإخوان وغيرها من الحركات والتنظيمات والجماعات السياسية التى تتخذ من الإسلام إطاراً أو أيديولوجية لها، لا بد من أن نمعن النظر فى المعارك الفكرية التى شهدتها مصر على مدار القرن العشرين. وإذا فعلنا ذلك نخرج بنتيجة عريضة تلخص المشهد العام للنزال الفكرى الذى شحذ الهمم وأجلى العقول وألهب الحناجر وأوغر الصدور، وهى أن التحديات التى طرحها أصحاب الأفكار «غير المألوفة» كانت دوماً أكبر من الاستجابات التى جاد بها من تصدوا لتلك الأفكار ومنتجيها، ليس لأن أتباع الفريق الأول أقوى حجة وأنصع برهاناً وأثبت مراساً وأسلس عرضاً، بل لأن أغلب أنصار الفريق الثانى لم يحسنوا اختيار أداة النزال، مما قاد فى النهاية إلى ترك هذه المعارك من دون حسم، وجعل توابعها تتجدد من آن لآخر، حتى مع حلول القرن الحادى والعشرين، وجعل كثيرين يشعرون أننا نحرث البحر أو نتحرك فى المكان نفسه. وتحت هذه النتيجة الكلية هناك استنتاجات فرعية، لا تخطئها عين بصيرة، ولا يهملها عقل فهيم، يمكن سردها على النحو التالى: 1- كل المحاولات التى رمت إلى مواجهة الفكر بغير الفكر انتهت إلى عكس ما قصد أصحابها. فالكتب التى حوربت إما باتهام أصحابها بالكفر والمروق أو الخيانة والعمالة، وكانت الدوافع السياسية أكبر من العناصر الفكرية فى التصدى لها، باتت أكثر شهرة وأوسع رواجاً، وبدا أصحابها «أبطالاً» حتى فى نظر بعض العوام، وحصدوا من المكانة ما لم يكن بوسعهم أن يبلغوا لو ظهر من يفنّد أفكارهم، وكثير منها متهافت الصنعة ضعيف البنيان، عن طريق الرأى العلمى الذى يستخدم أدوات البحث الحديثة، وينطلق من اقتناع تام بأن الطريق أمام البحث المنهجى يجب أن يكون عريضاً، خالياً من أى عثرات. 2- إن الحكم على كثير من الأفكار التى دارت حولها تلك المعارك، لم يخلُ أحياناً من التربص الذى صنعته الضغائن الشخصية، والسعى إلى تصفية الحسابات، والانتصار للمصالح الضيقة، حتى لو كان هذا على حساب الحق والحقيقة. 3- إن التعامل مع نوايا من أثاروا تلك المعارك الفكرية على أنها «خبيثة» على الدوام مسألة تفتقد إلى الدقة، وتحتاج إلى مراجعة تامة، وتتطلب تفاديها مستقبلاً. فبعض هؤلاء وقع ضحية لنقص المعلومات وتشويهها أو التأويلات الخاطئة للنصوص، أو التسرع فى إصدار الأحكام. وبعضهم أراد أن يدافع عن الإسلام فراح يجتهد، وكان يجب التعامل مع ما أنتجه على أنه «اجتهاد خاطئ» وليس مؤامرة لتشويه الإسلام أو النيل من الهوية المصرية. وبعضهم كان يرمى إلى منع آخرين من استغلال الإسلام فى تحصيل مكانة سياسية أو مكاسب مادية، وبعضهم أراد أن يلقى حجراً فى بحيرة الفقه الراكدة ليمنعها من التعفن، بفعل الفجوة الزمنية الواسعة بين تخريج الأحكام وحركة الواقع المعيش. وهناك من كان به علة من نقص فأراد أن يلفت الانتباه إليه فتجرأ على العقيدة، وصدم الناس فى دينهم، واتبع مبدأ «خالف تُعرف»، طارحاً أفكاراً غريبة لا دليل عليها، وليس بوسعها أن تصمد أمام أى حجة. 4- كثير من أصحاب هذه الآراء حادوا عنها، بعضهم انقلب عليها مائة وثمانين درجة، مثل خالد محمد خالد، الذى ألّف كتابا بعنوان «دين ودولة» تراجع فيه تماماً عما جاء فى كتابه «من هنا نبدأ» من اقتناع بفصل الدين عن الدولة، وبعضهم راح يعدل جزئياً فى أفكاره مثل طه حسين، الذى أعاد طبع «فى الشعر الجاهلى» بعد أن حذف منه ما أغضب الناس، لكنه لم يفعل الشىء نفسه حيال كتابه الآخر «مستقبل الثقافة فى مصر»، الذى كانت نقطة الشد والجذب فيه تدور حول «الهوية» وليست «العقيدة». أما منصور فهمى فصدمه ما قوبل به من «استهجان اجتماعى» فراح يعيد قراءة المراجع التى اعتمد عليها فى أطروحته للدكتوراه عن «المرأة فى الإسلام» فاكتشف أنه لم يتأنَّ فى الإحاطة بكل ما جاء به النص الإسلامى من قرآن وسنة، وما أنتجه الفقهاء فى هذا الشأن، فلما أحاط علماً بكل ما يتعلق بموضوع بحثه، غيّر أفكاره، وتحول إلى الدفاع عن الإسلام، لكن هذا لم يمنعه أن يظل حتى آخر أيام عمره غاضباً من عدم توافر حرية الفكر وحق الاجتهاد. وهناك من أصر على موقفه حتى آخر أيام حياته، مثل الشيخ على عبدالرازق، الذى بدا واثقاً مما انتهى إليه فى كتابه الصغير الأثير «الإسلام وأصول الحكم». ومعنى هذا أن الجدل الفكرى، ومقارعة الحجة بالحجة، وتوافر شروط النقد الذاتى، كفيلة بتعديل ما اعوجّ من فكر، وتقويم ما شذّ من رأى. أما الإرهاب الفكرى، ورمى الناس بالفسوق والخيانة، قد يؤدى إلى عناد حتى ولو فى الباطل، بل يساعد ضعاف النفوس على تحقيق ما يسعون إليه من شهرة أو مال. (ونكمل غداً إن شاء الله تعالى). نقلاً عن "الوطن"
GMT 14:09 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
تركيا في الامتحان السوري... كقوة اعتدالGMT 14:07 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
كيف نتعامل مع سوريا الجديدة؟GMT 14:06 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
سيناء فى عين الإعصار الإقليمىGMT 14:04 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
تنظير في الاقتصاد بلا نتائج!GMT 10:09 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
جنبلاط والشرع وجروح الأسدينGMT 10:08 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
بجعة سوداءGMT 10:07 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
عن «شاهبندر الإخوان»... يوسف نداGMT 10:05 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
لبنان... إلى أين؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©