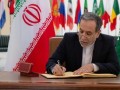الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
كلمتى أمام مؤتمر المثقفين

عمار علي حسن
اعتدت على مدار مشاركاتى فى محافل علمية وأدبية تفضيل الارتجال على القراءة، والشفاهية على الكتابة، لكننى فى هذا المقام والمكان واللحظة أجد نفسى فى مسيس الحاجة إلى أن أخرج على ما ألفته، وأتمرد على ما سلكته، وأقرأ على أسماع وأفهام حضراتكم مداخلتى، ربما لأتجنب الإسهاب الممل أو الإيجاز المخل، وربما لأنها المرة الأولى فى حياتى التى أتيح لى أن أقول كلمتى هنا فى حدث مثل هذا، كتلميذ أمام أساتذته، أو كمريد أمام شيوخه، أو كواحد على الدرب، وربما لأننى أعطيت نفسى الحق فى أن أصرخ بكل ما أوتيت من قوة، وكلى يقين بأن صرختى لن تذهب سدى، ولن تغادر بلا جدوى. أياً كانت حساباتى فإننى أتصور أو أتوهم أن ما سأنطق به قد يستحق أن يُسمع، أو على الأقل يشفى صدرى، ويريح ضميرى، وقد يفتح باباً للإفاضة والإضافة. علينا ابتداءً أن نعترف بأن الثقافة المصرية قد انحدرت إلى مستوى مخيف، رغم حديث رسمى مستفيض عن التحديث والتنوير والإصلاح، فالواقع العملى شهد بجلاء غياب مشروع ثقافى يليق بأعرق دولة فى تاريخ الإنسانية، وأكد بما لا مجال لشك فيه عدم وجود أى استراتيجية ثقافية تخرج مصر من ضيق الآنى والحالى إلى براح الآتى والتالى، وتعزز ثقافتها الوطنية لتصد وترد الثقافات الغازية الموزعة على تفلت ونزعة استهلاكية ظاهرة وتشدد فقهى مقيت. ومن أسف أن عدداً كبيراً من المثقفين قد انسجموا أو تواطأوا مع هذا الوضع المزرى، وظلوا سادرين فى صمتهم المريب وانتفاعهم المخزى، ورضوا بتراجع دورهم الطليعى، واكتفوا بالفتات المتاح الذى تهبه الفرصة وقبلها السلطان الجائر، وتماهوا بشكل مثير للاستغراب والاشمئزاز فى آن مع تحول الثقافة، فى الغالب الأعم، إلى عمل مظهرى يتقدم فيه الشكل على المضمون، والمهرجان على الأثر، والعابر على المقيم، والفرد على الجماعة، والتشتت على التوحد، والأثرة على الإيثار، والأمس على الغد، فى ظل غياب التفاعل الخلاق بين المؤسسات الثقافية الرسمية والواقع المعيش، ومع الاكتفاء برطانة زاعقة وبلاغة جوفاء، فى ضجيج بلا طحن، على حساب عمل يتوخى العلم ومنهجه، وممارسة تنتصر للنهوض والتقدم والتحقق، وتصور ينحاز إلى أشواق المصريين جميعاً إلى الحرية والعدالة والكفاية والكرامة والسمو الأخلاقى والامتلاء الروحى. إن دور وزارة الثقافة يجب ألا يُختزل فى نشر مشروط للكتب، ولا فى التوزيع الموسمى للجوائز، ولا فى إنشاءات وترميمات ينهض بها المقاولون وتحسب فى سجل إنجازاتهم، وتتقدم بها المبانى على المعانى، ولا فى محاولات مستميتة لتدجين أرباب الفكر والفن، بغية توظيفهم فى تبرير السياسات الاعتيادية الارتجالية القائمة مهما كانت هابطة، واستعمالهم فى تجميل التصورات القبيحة التى تشد كل شىء فى حياتنا إلى الوراء، وضمان سكوتهم عن أى قوانين وتشريعات تقيد حرية التفكير والتعبير والتدبير، ومحاصرتهم حتى يستسلموا للمحاولات الماكرة التى تزيح الثقافة كى تصبح شيئاً ثانوياً فى حياة المصريين المعاصرين، وتسعى إلى تفريغ كل عمل ثقافى من مضمونه، وتحاول إبعاد الفن والفكر عن أداء دورهما فى الأخذ بيد الناس وتبصيرهم وتنويرهم والانتصار لجهدهم الدؤوب فى سبيل تحسين شروط العيش، أو على الأقل فى سبيل توسيع الزنازين التى يحملونها فوق ظهورهم من فرط مآسى الحياة. إن من يمعن النظر فى حال مصر الثقافى طيلة العقود الفائتة سيصدمه على الفور تبخر الشعور بالانتماء من بين جوانح العديد من المثقفين، لفقدانهم الثقة فى قدرة المؤسسات الثقافية على تقديم شىء إيجابى، وسيكتشف هذا الفصام النكد بين قطاعات عريضة من منتجى الفنون والمعارف والحراك السياسى الذى كانت تموج به مصر بشكل لا يخفى على كل ذى عين بصيرة وعقل فهيم، وسيضنيه غياب مشروع ثقافى حقيقى لدى السلطة وفى برامج أحزاب المعارضة وممارساتها، وسيفجعه استشراء الروح الجامدة والمتزمتة على التفكير الدينى، بما يضرب فى مقتل الثقافة المصرية الراسخة والأصيلة، التى طالما انحازت إلى الوسطية والاعتدال، وحافظت على التسامح والتنوع الخلاق، وشجعت على الإنجاز. وستروعه كذلك حالة الاحتقان الطائفى والطبقى والجهوى التى راحت تتزايد يوما إثر يوم، وسيوجعه تخلى أغلب المثقفين عن الناس، مرة تحت وهم «موت الأفكار أو السرديات الكبرى»، ومرات تحت وطأة اللهاث وراء المجد الذاتى، وفق معادلة جهنمية تقول: «دعه يخطف دعه يمر»، أو تحت نير الحذر والخوف استجابة لهاتف الخائرين: «انحنوا للعاصفة». إن الوقت قد حان لانخراط المفكرين والمبدعين فى بناء تصور بديل، يعيد الثقافة إلى أصحابها، وينزعها من التجار الذين حولوها إلى سلعة رخيصة وتكسَّبوا بها دون أى وازع من دين أو وطنية أو أخلاق. وصمتت السلطة على هذا المسلك الوعر، لأنها لم تكن تروم نهضة ولا تقدماً، إنما كانت تستخدم الثقافة والمثقفين مجرد قلائد للزينة تضعها على جسدها المتحلل، لعل الناس لا يلتفتون إلى تداعيه وتعفنه، وينشغلون بهذه الزينة العابرة. وكانت تستخدم العلم مثل «الصلصة» التى توضع على السمك المشرف على التعفن لعلها تجعله مستساغاً. وكان من الخطل والخطأ بل والخطيئة أن تتداعى وزارة الثقافة لتكون مجرد وزارة للمثقفين، بينما يتراجع نصيب الفرد المصرى من ميزانية الوزارة ليقترب من العدم، ويتدهور نظام التعليم فيعتمد على الترديد لا التجديد، وينسى القائمون عليه ذلك المثل الصينى الرائع الذى يقول: «أخبرنى سأنسى. أرنى فقد أتذكر. أشركنى سأعى وأفهم». وعلى التوازى اكتفى الباحثون بجمع المتفرق، وترتيب المبعثر، وتطويل المختصر، واختصار المطول، وإن أحسنوا يقومون بإتمام الناقص، وإجلاء الغامض، لكن أغلبهم لم ينتقل أبداً إلى نقد السائد، وإبداع الجديد، فاتسعت الفجوة بيننا وبين الأمم التى ضاعفت معارفها ومواردها وإنتاجها فى العقود الثلاثة الماضية بأشكال وأحجام وأنواع مذهلة. ولا يسعنى فى هذا المقام إلا تذكيركم بأيام توقيع صك على بياض لنظام «مبارك» فى تسعينات القرن المنصرم من أجل مواجهة الإرهاب، فانتهى الأمر إلى دولة باطشة قاهرة مستهينة بالعلوم والفنون، لا ترى مستقبلاً لها إلا على أطراف هراوة شرطى متجهم. أيامها كان يمكن للمثقفين أن يفرضوا شروطهم، ويقولوا للسلطان بملء الأفواه: إننا لن ننتصر فى المعركة ضد الإرهابيين إلا بالعلم والحرية والعدل الاجتماعى واستقلال القرار الوطنى واحترام إرادة الشعب. وعلى المثقفين اليوم أن يعوا هذا الدرس جيداً ولا يُلدغوا من الجحر مرتين، لأن من يدفع الثمن هو مصر الحبيبة الغالية، ولن يغفر الشعب ولا التاريخ ولا التلاميذ لمن ينسى أو يهمل أو يقع فى الفخ من جديد. لقد قامت الثورة السياسية، فى يناير 2011 ويونيو 2013، فانخرط فيها بعض المثقفين والدهشة تعلو وجوههم من قدرة شعب كان من بينهم من كفر به، أو تصور غيابه الأبدى عن المشهد، ورأوا بعيونهم رئيسين وراء القضبان، وهتف أغلبهم من الأعماق: «فعلها الشعب المعلم»، لكن هناك من عاد، أو يستعد للعودة إلى سابق عهده من الانكفاء والانزواء، وممارسة رذيلة «حضور الذات» أو تضخمها، أو تقديم الخاص على العام وما للبيت على ما للوطن، من دون أن يدرى أن الثقافة بوسعها أن تصلح ما أفسدته السياسة. واليوم ونحن نعيش صراعاً ضارياً فى معركة الهدم والبناء، وتنافساً شديداً متعجلاً وانتهازياً بين التيارات السياسية على قطف الثمار أو الحفاظ على المكاسب والمنافع الزائلة، وإرباكاً أمنياً واقتصادياً كان متوقعاً، وطغياناً واضحاً من بعض الماضى على الحاضر. من الضرورى أن يستعيد المثقفون دورهم الطليعى، ويؤمنوا بأن بلدنا فى حاجة ماسة إلى ثورة ثقافية، تشكل رافعة ضرورية وواجبة لاستكمال انتصار الثورة السياسية، وتخط معالم مشروع ثقافى، جامع مانع، يحفظ لمصرنا الغالية قيمتها، ويرفع قامتها بين الأمم، ويلبى رغبة متجددة للذين يعيشون على ضفاف النيل الخالد فى صنع المعجزات. نقلاً عن "الوطن"
GMT 14:09 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
تركيا في الامتحان السوري... كقوة اعتدالGMT 14:07 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
كيف نتعامل مع سوريا الجديدة؟GMT 14:06 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
سيناء فى عين الإعصار الإقليمىGMT 14:04 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
تنظير في الاقتصاد بلا نتائج!GMT 10:09 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
جنبلاط والشرع وجروح الأسدينGMT 10:08 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
بجعة سوداءGMT 10:07 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
عن «شاهبندر الإخوان»... يوسف نداGMT 10:05 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر
لبنان... إلى أين؟"المركزي المصري" يتيح التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
القاهرة ـ العرب اليوم
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شب...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس ـ مصر اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المميزة. و�...المزيدترامب يحدد موقفه من حظر "تيك توك" لمواصلة العمل في الولايات المتحدة
واشنطن ـ مصر اليوم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئ�...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©