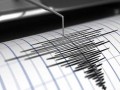الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
حروب الطوائف على السلطة وحروب التقاسم الدولي للمشرق العربي

طلال سلمان
حتى مناسك الحج اغتسلت هذا العام بدماء المسلمين التي اختلطت بدماء الأضاحي من خرفان عيد الأضحى المبارك. كأنما لا تكفي دماء الألوف المؤلفة من ضحايا الإرهاب بالدين الذين يتساقطون على امتداد أرض المشرق وبعض المغرب، فتسقط معهم بعض دولهم وتُفرض جاهلية جديدة باسم الدين الحنيف على الأرض التي أعطت العالم أنبياء الهداية، الذين بشروا بالرسالات السماوية ونشروا التوحيد وكلمة الحق في أربع رياح الأرض.
المفجع أن فصولاً جديدة من التاريخ المستحدث والذي يشكل إخراجاً للأمة من موقعها الطبيعي تكتب الآن، تحت رايات إسلامية مزورة. هكذا، فإن المذبحة تستهدف الإسلام والعروبة معاً... فوضع العروبة في مواجهة الإسلام، والإسلام في مواجهة العروبة، يعني تجريد العرب من هويتهم القومية ومن دينهم الحنيف في آن معاً، بتصوير العروبة وكأنها العدو المبين للإسلام والعكس بالعكس.
بعد ذلك، يسهل تفسيخ الإسلام إلى مذاهب متصارعة وإشغال السنة بحرب لها الأولوية المطلقة ضد الشيعة (بعنوان إيران) التي ستجد ميادين جاهزة لها بالتوارث التاريخي في بلاد الشام خاصة (العراق وسوريا وبالاستطراد لبنان). وفي غمار هذه الحرب، يسقط العدو الإسرائيلي سهواً، ويجري إلباس الإيراني أثواب العداء التي كانت للصهيونية ذات يوم، ويصوَّر التركي ـ الذي يضفي عليه أردوغان ملامح السلطان العثماني ـ وكأنه حامي حمى السنة من الشيعة الصفويين.
في السياق ذاته، ينتبه «الوهابيون» في المملكة المذهبة إلى «الزيود» في اليمن الذين يمكن اعتبارهم واحدة من الفرق الشيعية، فيتخذون من «حليفهم السابق» الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ذريعة لشن الحرب عليهم بعنوان «التغلغل الفارسي» في الجزيرة العربية وتهديد أمن الديار المقدسة.
تختفي السياسة تحت أقنعة الحرب الدينية، بل المذهبية، وتغلّب المصالح المباشرة للأنظمة الحاكمة مقولة «الجهاد»، ويتفاقم الصراع متخطياً حدود السياسة إلى الحرب جواً وبحراً وبراً، بينما «داعش» يوسع مساحة احتلاله ملتقطاً شعار «الجهاد» من أجل إحياء الإسلام ببعث «الخلافة» التي مثلت سبباً لحرب أهلية مفتوحة في التاريخ العربي ـ الإسلامي، وأُسقطت نهائياً بعدما انتفت الحاجة إلى التمويه فصار «الخليفة العربي» سلطاناً عثمانياً.
تقتتل أنماط من الإسلام السياسي، إيراني ـ فارسي ـ شيعي، تركي ـ عثماني ـ سني، إخواني ـ وهابي ـ أصولي، على الأرض التي كان أهلها يسمونها «الوطن العربي» ذات يوم ويحلمون بتوحيدها تاركين لأشقائهم المسيحيين أن يكتبوا لها «العقيدة القومية»، بداية مع رواد النهضة مطلع القرن العشرين، وهم الذين أحيوا فكرة «العروبة»، ثم «القومية» مع أنطون سعادة الذي اكتفى بالهلال الخصيب (لبنان وسوريا والعراق) وصولاً إلى زكي الأرسوزي وميشال عفلق ورفاقهما الذين بشروا بـ «البعث»: أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة... وصولاً إلى الدكتور جورج حبش و «حركة القوميين العرب».
ولقد مكن لهذه الدعوة وجعلها قاعدة للنضال القومي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مدعوماً بالغرب الأميركي والشرق السوفياتي، بعد الحرب العالمية الثانية، أما الذروة التي حولت الفكرة إلى منهج سياسي فجاءت مع العدوان الثلاثي على مصر، في خريف العام 1956، والانتصار التاريخي الذي تحقق للعرب بقيادة جمال عبد الناصر، وأضفى على «فكرة» العروبة، عبر الموقف العربي الجامع، الطابع السياسي لتكون منطلق العمل من أجل الوحدة السياسية، التي سرعان ما ارتجلتها الحماسة والمأزق الذي كانت تعيشه سوريا تحت حمى الانقلابات العسكرية، فقامت الجمهورية العربية المتحدة التي سقطت قبل اكتمال سنتها الرابعة.
لكن ذلك قد بات حديثاً في الماضي الذي لن يعود.. وها هم العرب يخسرون «دولهم»، التي أقيمت ذات يوم بقرار أجنبي وعلى حساب أحلامهم بالوحدة ودولتها الجامعة العتيدة، والتي تتهاوى اليوم عبر حروب أهلية مفتوحة، بينما تندثر العروبة والوحدة وكذلك «الوطنية» التي تم النظر إليها، ذات يوم، على أنها «كيانية» تُستولد قيصرياً، وبرعاية دول مؤثرة وذات مصالح في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة.
ومع «الدول» يخسر العرب هويتهم الجامعة، فتغلب «الكيانية» التي يسهل تحولها إلى عداء مع التاريخ والجغرافيا وإنكار للذات والأرض، وإلى الذوبان في «أممية» يغلب عليها الانبهار بالغرب الأميركي مع خجل من «الذات» والتنكر لكل ما يحدد «الشخصية الوطنية» ويميزها، وكلّ ما كان، ذات يوم، مصدراً للفخر والتباهي بأمجاد الماضي والسبق إلى الحضارة بالثقافة والعلوم والتعلق بالأرض باعتبارها مقدسة ومصدراً للاعتزاز بالهوية.
لا أحد بين «العرب» يعترف الآن بأنّه «عربي»!
من الكيانية إلى الطائفية فإلى المذهبية، فإذا العرب أشتات من القبائل المقتتلة، يستدعون الأجنبي لحماية بعضهم من البعض الآخر.
وكما على الأرض كذلك في السماء، تتجاور أساطيل الطيران الحربي، أميركية بطيار أو من دونه وبريطانية وفرنسية وأوسترالية وأخيراً روسية تجمع إلى الفضاء الأرض في الساحل السوري، بذريعة شن الحرب على «داعش»، فتسقط الحدود التي طالما كان اختراقها ـ ولو بالمصادفة ـ يستنفر الجيوش ويبرر إعلان حالة الطوارئ استعداداً للحرب، بين سوريا والعراق، مثلاً.
صارت الحرب على «داعش» هي الذريعة لمشاركة الأسطول الجوي الروسي مع أساطيل دول خصومه في الغرب في حماية سماء «الهلال الخصيب» ودولتيه سوريا والعراق.
وصارت الحرب في سوريا وعليها أرض التلاقي بين الدول، شرقية وغربية، لمنع انهيار الدولة فيها، واستطراداً في العراق. وإن لم تكن هذه الحرب ضمانة لوجود الدولتين بصيغتهما المعروفة منذ اتفاق «سايكس ـ بيكو» في العام 1916. فالأحاديث تترى، في أروقة الأمم المتحدة، كما في عواصم بعيدة، عن مشاريع لتقاسم مناطق النفوذ، مرة أخرى، عبر «اتفاق جنتلمان» يحفظ للدول الكبرى مصالحها، بغض النظر عما سيكون مستقبل دولتي العراق وسوريا: هل يبقى الكيان موحداً عبر صيغة فيدرالية ـ طوائفية لنظام الحكم، أم لا بد من اجراء تعديل على النظام وفيه من دون المس بوحدة الدولة؟
وهكذا تفرض «الدول»، وبحسب مواقع نفوذها، صيغة جديدة للحكم الفيدرالي في كل من سوريا والعراق، مع احتمال نقل هذه الصيغة، إذا ما نجحت، إلى اليمن التي تمزقها الآن «حرب الأمل» التي تشنها السعودية ومعها دول التحالف الخليجية أساساً، على هذه الدولة الفقيرة والمفقرة، فتذهب بعمرانها، الجديد وهو عارض، والتاريخي وهو نادر المثال، كما بوحدة شعبها التي كانت دائماً مهددة والتي قد تشكل الحرب الجديدة فرصة لإعادة تقسيمه إلى دولتين، واحدة في الشمال حيث الغلبة للزيود، والثانية للشوافع في الجنوب.. فإذا نجح هذا المثال يمكن اعتماده غداً في أنحاء أخرى من الوطن العربي (ليبيا، مثلاً، إذا ما تعذر اعتماده في سوريا ـ والعراق..).
ومع هذه الإفاقة المصنعة للمذاهب وللطوائف، ومعها الأقليات الطائفية المنتشرة في مختلف أنحاء المشرق العربي، ترتفع أصوات طبيعية أحياناً ومصنعة أحياناً أخرى تطالب باعتماد الطائفية أساساً للكيانات السياسية. ووفق هذه القاعدة يمكن الحديث عن 3 او 4 سورِّية (كردي، عربي، سني، علوي)، وعن 3 او 4 عراقيّة (كردي، عربي، سني، شيعي)، أما لبنان فيستحيل تقسيمه جغرافياً على أساس طائفي، لكن تقسيم الحكم على قواعد طائفية ممكن بل واجب، بحيث تُعطى فيه أفضلية مطلقة للأقليات المسيحية، باعتبار ان الأقليات الإسلامية قد نالت «حقوقها» في الأقطار المجاورة!
هكذا حال المشرق العربي، إذاً، في هذه اللحظة «التاريخية»: العالم كله، شرقاً وغرباً يحكمه بطيرانه، من فوق، بذريعة قتال «داعش» وهو التنظيم الذي يسيطر بالنار على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وأنظمة أضعفتها الحرب الأهلية فلم تعد قادرة على رفض المساعدة الأجنبية، جوية عموماً مع تواجد عسكري محدود وإن كان حاكماً على الأرض.
ولا شك أن اللقاءات التي شهدتها وتشهدها كواليس الأمم المتحدة، هذه الأيام، تمهد للصياغة الأخيرة لاتفاقات تقاسم الأرض العربية، بثرواتها المعلنة أو الكامنة... وسيكون العرب الطرف الأضعف، لأن من كانوا أقوياء من حكامها قد غرقوا في حروب دموية مكلفة عجزوا عن كسبها وإن عجز خصومهم عن إلحاق الهزيمة بهم... وهكذا حانت لحظة التسوية التي سيصوغها «الأقوياء»، وهم هنا الدول الكبرى التي توزَّع طيرانها السماء العربية، والتي سيكون لها رأيها الحاسم في أي نظام يبقى، وبأي شروط، وربما تجاوز ذلك إلى الكيانات وحدودها، لا سيما ان هذه الكيانات تحتوي واحدة من أخطر الثروات في هذا العصر: النفط والغاز، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي.
وبالمصادفة، يأتي الاحتفال المبهر في موسكو بإنجاز بناء أكبر مسجد للمسلمين في روسيا، وقد شارك فيه إلى جانب الرئيس الروسي بوتين الرئيس التركي أردوغان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وإسرائيل هي الرابح الأكبر، مع أنها لا تجلس مع الأقوياء الذين يبتدعون الآن صيغة التقاسم.
GMT 08:58 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
سبع ملاحظات على واقعة وسام شعيبGMT 08:47 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
المالك والمستأجر.. بدائل متنوعة للحلGMT 08:43 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
إيران ولبنان.. في انتظار لحظة الحقيقة!GMT 08:40 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
أوهام مغلوطة عن سرطان الثديGMT 07:32 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
ماذا تفعلون في هذي الديار؟GMT 07:31 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
من جديدGMT 07:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
رُمّانة ماجدة الرومي ليست هي السبب!GMT 07:29 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
لقاء أبوظبي والقضايا الصعبة!مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز �...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©